بقلم:سالم مشكور
لا يكفي أن تعالج الطائفية والتطرف وباقي أمراض التفريق والتمزيق بإجراءات أمنية أو ملاحقات قضائية، خصوصاً عندما تتفشى هذه الامراض الفتاكة في المجتمع. هذه الاجراءات تنفع لمعالجات آنية ثم تبقى كإجراءات رادعة في المستقبل، تبقى إجراءات معالجة، بينما الحاجة الماسة هي اتخاذ إجراءات وقاية من ظهور هذه الامراض مجددا.
في الدول متنوعة الهويات الاجتماعية والدينية والمذهبية، تكون الاختلافات مضبوطة بجملة أمور تجعل من الاختلاف سبب غنى وليس فرقة. أولها التعليم بكافة مراحله، الذي يوفر مساحة عريضة للتلاقي والنظر الى الآخر كحالة ثراء فكري وحضاري. تدعم ذلك القوانين التي تردع أي خروقات لهذه الحالة. لا نتحدث هنا عن الدول التي تحكمها أنظمة دكتاتورية تتصرف بعقلية قمعية اقصائية (طائفية وعرقية)، كحال النظام السابق. في هذه الحالة فان الدين والتاريخ يقدمان الى الطلبة من زاوية واحدة ووفق ما يخدم سياسة الحاكم ومنهجه. هنا تتحول الاختلافات الى محرك للنفاق عبر تظاهر بقبول وتبنٍ شكلي للمطلوب سلطوياً مع رفض داخلي وتبنٍ معاكسٍ يشكل مصدراً للكراهية والحقد والرفض الخفي تنفجر إذا ما تعرض النظام القمعي الى الضعف أو الانهيار على شكل صراعات وحروب. في الانظمة الديمقراطية، بل وحتى غير الديمقراطية، التي تريد الخروج من حالة الفرقة والصراع الداخلي، والوقاية منه مستقبلاً، فان الأنظار تتجه الى مصادر صناعة الوعي والمعرفة لضبطها باتجاه خلق جيل نظيف من الخلاف والنفاق، إيجابي في علاقاته البينية، رافض لكل ما يزعزع حياته واستقراره. يتضح ذلك في المجتمعات التي أنهكتها الصراعات الداخلية حتى وصلت الى مرحلة الرفض لكل مسببات هذه الصراعات والخلافات، تصل الى حد التطرف المضاد أحياناً، كما في حالات التمرد على الأديان، بل حتى على الايمان، التي تنشأ عادة بعد الحروب الدينية أو الطائفية. حدث ذلك في لبنان بعد الحرب الاهلية التي كانت صبغتها طائفية (دينية ومذهبية)، وفي العراق الذي خاض مثل هذه التجربة القاسية. عادة ما يتداخل السياسي مع الديني في هذه الصراعات، وغالباً ما يكون الدين والمذهب أداة يستخدمها أمراء الحروب الاهلية لتنفيذ مصالح شخصية أو حزبية أو تناغم مع مصالح دول أخرى. هنا تتجه جهود المعالجة الى الحاضنة الاجتماعية لهذه الصراعات بإجراءات آنية عبر القوانين الصارمة المجرّمة لكل فعل تفريقي وأخرى وقائية عبر التحكم بمصادر المعرفة الأساسية وهي المدرسة ومقرراتها التعليمية. المعالجة هنا تكون على خطين: المنهج التعليمي، الذي يعني طريقة تقديم المعلومة الى الطالب التي يجب أن تعتمد تحفيز التفكير وليس حقن المعلومات في ذهنه بطريقة التلقين، والثاني، المقرر المدرسي وهو الكتاب الذي يوضع بين يدي الطالب، وهذا ما يحتاج الى تنقية من كل ما يزرع بذور الخلاف والفرقة. الحديث هنا ينصب على مواد الدين والتاريخ والتربية الوطنية، السبب الرئيس في ظهور الخلافات الدينية والسياسية. البعض يذهب الى المطالبة بإلغاء تدريس الدين من الأساس. وآخر يراه ضروريا مع اجراء تعديلات جذرية. هذا النقاش شهدته الدول الغربية بعد خوضها حروباً طويلة، ويشهده لبنان منذ عقود والعراق منذ سنوات. التاريخ يحتاج الى رواية محايدة تصف ولا تقيّم، أما اصلاح مادة التربية الدينية فيواجه أسئلة مصيرية مثل: أي دين ندرس ووفق أي مذهب ونحن مجتمع متعدد الديانات والمذاهب؟ وهل المطلوب تعليم العبادات والشريعة أم أساسيات الدين وقيمه الأخلاقية، وهي مشتركات بين كل الأديان؟، أم نقدم الدين كمعرفة لتثقيف المجتمع ومساعدته على الانفتاح على بعضه ومعرفة أحد مصادر غناه؟ أسئلة تحتاج الى أجوبة حاسمة ليتم وفقها بناء مقررات ومناهج دراسية تعيد بناء المجتمع، وتحصنه مما يفرقه ويشتته. الكتاب المدرسي الحالي يشير في الغالب-الى أنّ أحداً من واضعيه لم يأخذ هذه الأسئلة بعين الاعتبار.














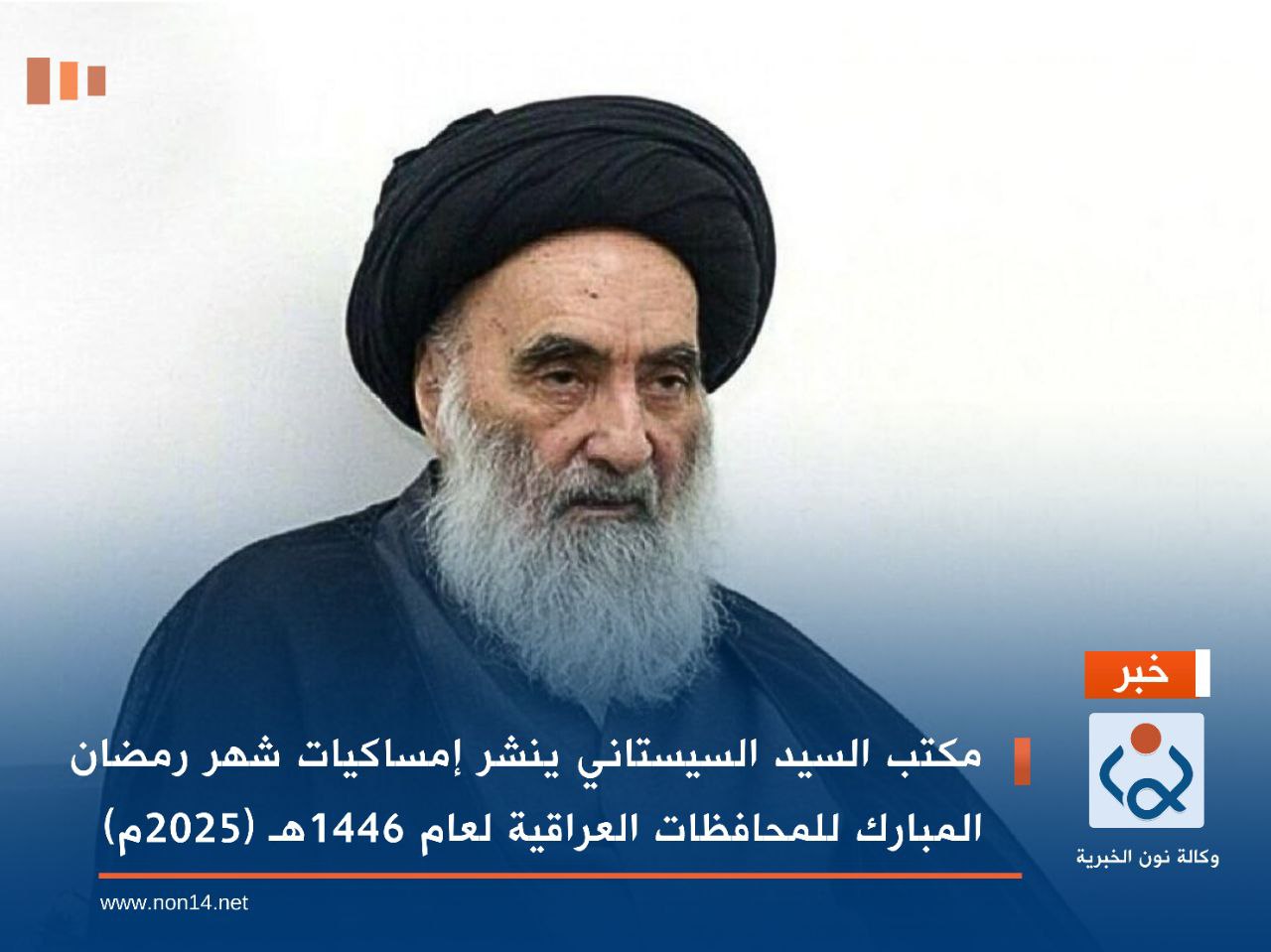




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!