يذكر لنا المؤرخون أن الإمام الحسين عليه السلام لما أثخن بالجراحات وقف ليستريح وقد ضعف عن القتال، إذ أتاه حجر فوقع في جبهته المقدّسة فأخذ الثوب ليمسح الدم عن وجهه، فأتاه سهم محدّد مسموم له ثلاث شعب، فوقع السهم في قلبه فقال الإمام الحسين (ع): بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص)... ثم أخذ السهم فأخرجه من قفاه فانبعث الدم كالميزاب فوضع يده على الجرح فلما امتلأت رمى به إلى السماء، فما رجع من ذلك الدم قطرة، وما عرفت الحمرة في السماء حتى رمى الإمام الحسين (ع) بدمه إلى السماء... (كما ينقل صاحب البحار في الجزء 45 ص 53)
لماذا لم يترك الدم يُسكب على الأرض بل رماه إلى السماء؟ لعل الجواب يكمن في أنه لو تركه يتدفق على الأرض لما بقي على وجهها مخلوق بل لما بقيت الأرض أرضاً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن دمه الطاهر لا تستحق الأرض أن تتلقاه لأنه أرفع منها ولأجلها خُلقت السماء بما فيها من أملاك وأفلاك، فالشيء يميل إلى جنسه: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [فاطر : 10]فإلى الله تعالى صَعَّد الإمام الحسين (ع) كلامه الطيب، وعمله الصالح رفعه عند من يملك العزة، فيعطيها لمن فدى نفسه في سبيله، ذلك المؤمن الذي ذاب في حب الله، فأحبه الله وتشفع لمحبيه كرامة له لما عمل وأخلص وضحى...
لهذا وكما جاء في الزيارة الصادرة عن المعصوم فإن دم الإمام الحسين عليه السلام بالخصوص قد سكن في الخلد وإقشعرت له أظلة العرش...!
كيف حصل ذلك والدم هو تلك المادة الحمراء التي تجري في العروق، هل أن تلك المادة سكنت في الخلد وإقشعرت له أظلة العرش... ما الذي جرى حتى راح الدم ليسكنَ في الخلد؟ السر هو تجرد دم الإمام الحسين عن المادة تجرداً مطلقاً كما هو تجرد عنها في الحياة الدنيا، فصار الدم مجرداً فسكن في الخلد، أما أهدافه المعنوية التي ضحى من أجلها هي أولى بالخلود من دمه الطاهر، وهكذا فإن روحه المباركة فإنها فوق جنان الخلد راضية مرضية عند مليك مقتدر، وهذا يعني أن الإمام المعظم روحي فداه بلغ حداً صار الخلد فيه مسكناً ومأوىً حتى لدمه الطاهر...
وعلى أثر هذا السكن هناك اقشعرار، ومعناه: الانقباض وتغير اللون أو القيام والانتصاب من فزعٍ، فيقال لغةً: اقشعرت الأرض أي إنقضبت وتجمعت إذا لم ينزل عليها المطر... والملائكة حملة العرش قد تغير لونهم وانقبضت أرواحهم وسحنات وجوههم فوقفوا قياماً فزعين لمّا سكن دم الإمام المفدى عليه السلام... ما الميزة لهذا الدم الشريف حتى يسكن الخلد وتفزع منه الملائكة وتقشعر له أظلة - أي طبقات - العرش..؟
الميزة لأن كربلاء المقدسة أصبحت دوحة للعشق الإلهي والمواقف النبيلة الخالدة، ذلك المكان الذي جمع العرفان والعارفين، وإذا أردت التعرف على البعد العرفاني لكربلاء عليك التعرف على البعد السلوكي للإمام الحسين عليه السلام، وأعظم درس نتعلمه من ملحمة الطف أنها البوصلة الحقيقية لتمييز الحق الحسيني ضد الباطل اليزيدي، تلك البوصلة التي تدلنا الطريق وتنيره أمام السالكين والمتعطشين، أولئك الذين يرنون الاغتراف من معين الإيثار والإنعتاق من ربقة العبودية لغير الله سبحانه تعالى.
منذ أن وطأت قدم الإمام الحسين عليه السلام أرض كربلاء لحين شهادته وأسر أهل بيته وأطفاله، فإن هذه البرهة الزمنية القصيرة التي غيرت مجرى التاريخ مليئة بدروس المعرفة والإيثار والتجرد عن الماديات الزائفة، تلك الدروس التي اتسمت بها روحية الإمام وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وتحملت لأجل تحقيق ذلك كل المصائب والمحن وتدرعت بجلباب الصبر والمقاومة والرضا والتسليم لإرادة الله، كل ذلك حصل من أجل إنقاذ العباد من حيرة الضلالة إلى واحة الهداية وكذلك للقاء المحبوب والذوبان بذاته المقدسة والانقطاع عما سواه...
منذ أن طرقت كربلاء مسامع الإمام الحسين عليه السلام، ازداد تعلقه بها، لأنه على موعد معها، وهي الطريق الأقصر للوصول إلى مبتغاه، وكلما اقتربوا من ساعة الصفر الحاسمة كلما كان اشتياقهم أكبر للقاء الحبيب، وفي ليلة عاشوراء، ليلة الحب والمناجاة، ليلة العشق الإلهي، تراهم ما بين راكع وساجد وتال للقرآن ومناج لربه، تراهم قد توجهوا للمحبوب والمعشوق وارتبطوا به وأوصدوا الباب على كل من يعكر صفو خلوتهم تلك...
وعندما أسفر صبح عاشوراء عن وجهه، وعندما احتدمت المعركة، فإن أمواج العشق والوصال أخذت تضرب بربان وراكبي سفينة العشق الإلهي، من دون أن تنال من عزيمتهم وإصرارهم على المضي قدما في تحقيق أهدافهم النبيلة، تلك العزائم والإرادات الفولاذية لم تهن ولا تنكل بالرغم مما كان ينتظرها من المصير المحتوم، والإمام الحسين عليه السلام يرى كل تلك المصائب والمحن ولسان حاله:
تركت الخلق طرا في هواكا***وأيتمت العيال لكي أراكا
ولو قطعتني بالحب إربا***لما مال الفؤاد إلى سواكا
إنه يتخطى الموانع والحجب التي تقف عائقا أمامه لوصال الحبيب، لم تلهه عن ذلك ضرب السيوف وطعن الرماح ورضخ الحجارة، إنه يتلقى كل ذلك المصاب والألم برحابة صدر وتسليم منقطع النظير لإرادة الله وقضاءه وقدره، لأنه يدرك بأن ذوبان نفسه بالحالة الإلهية هي خير مسكن لكل تلك الآلام والمصائب، وطالما كان يحمل بين جنبيه تلك الروحية العظيمة وذلك الخلق الرفيع...
كان همه الأول والأخير رضا المحبوب، ولتحقيق هذا الهدف السامي لم يكن يشعر بالألم والنصب والتعب، بل كان يزداد تألقا وإيمانا وازدهارا، وتتجلى تلك الروحية العظيمة التي كانت تنتابه في آخر لحظات حياته عندما كان يجود بنفسه ويتمتم نشيد الشهادة، نشيد العشق والولاء: قال أبو مخنف: بقي الحسين عليه السلام ثلاث ساعات من النهار ملطخا بدمه رامقا بطرفه إلى السماء وينادي: يا إلهي صبرا على قضاءك ولا معبود سواك يا غياث المستغيثين. (ينابيع المودة لذوي القربى ج3، ص82، للقندوزي).
هل ترغب أن تتعرف على دروس العشق والوصل الإلهي؟ وهل تريد أن تشاهد أرضا مليئة بمحطات العشق والحب الإلهي، وهل تتمنى أن تطوي رحلة مئة عام بليلة واحدة؟ وهل خطر ببالك فضاء تتنفس به الصعداء للقاء الحبيب؟
إذهب إلى كربلاء وتوجه إلى قبلة الإباء وتجول بين مراقد الأولياء الصالحين من أهل بيته وأصحابه، ستقتبس منهم معاني الإباء والبطولة وتخطي المصاعب فداء للدين والفضيلة والكرامة الإنسانية، وترتشف من أولئك الأبطال الأفذاذ نسائم الهدى والاستقامة، مثلما شمها الحر بن يزيد الرياحي، التي أحدثت تلك الهزة العنيفة في نفسه في أقل من يوم واحد، فقرر أن ينعتق من كل مغريات الدنيا الفانية، ويذوب بالعشق الحسيني الذي هو امتداد للعشق الإلهي وهو أقصر الطرق المؤدية إليه...
وعندما وصل إلى معشوقه الحقيقي فإنه قد تخطى الصعاب وأعطى المحبوب أغلى ما يملك وهو حياته، بعد أن قبل توبته بالرغم مما بدر منه من معاصي وذنوب طيلة حياته، فإنه قد أحدث انقلابا جوهريا في حياته ومصيره - وكذلك نحن نستطيع إذا ما أردنا ذلك- بتحوله من أسار المادة والشهوة والشيطان إلى وصال المعنى والفضيلة والرحمن...













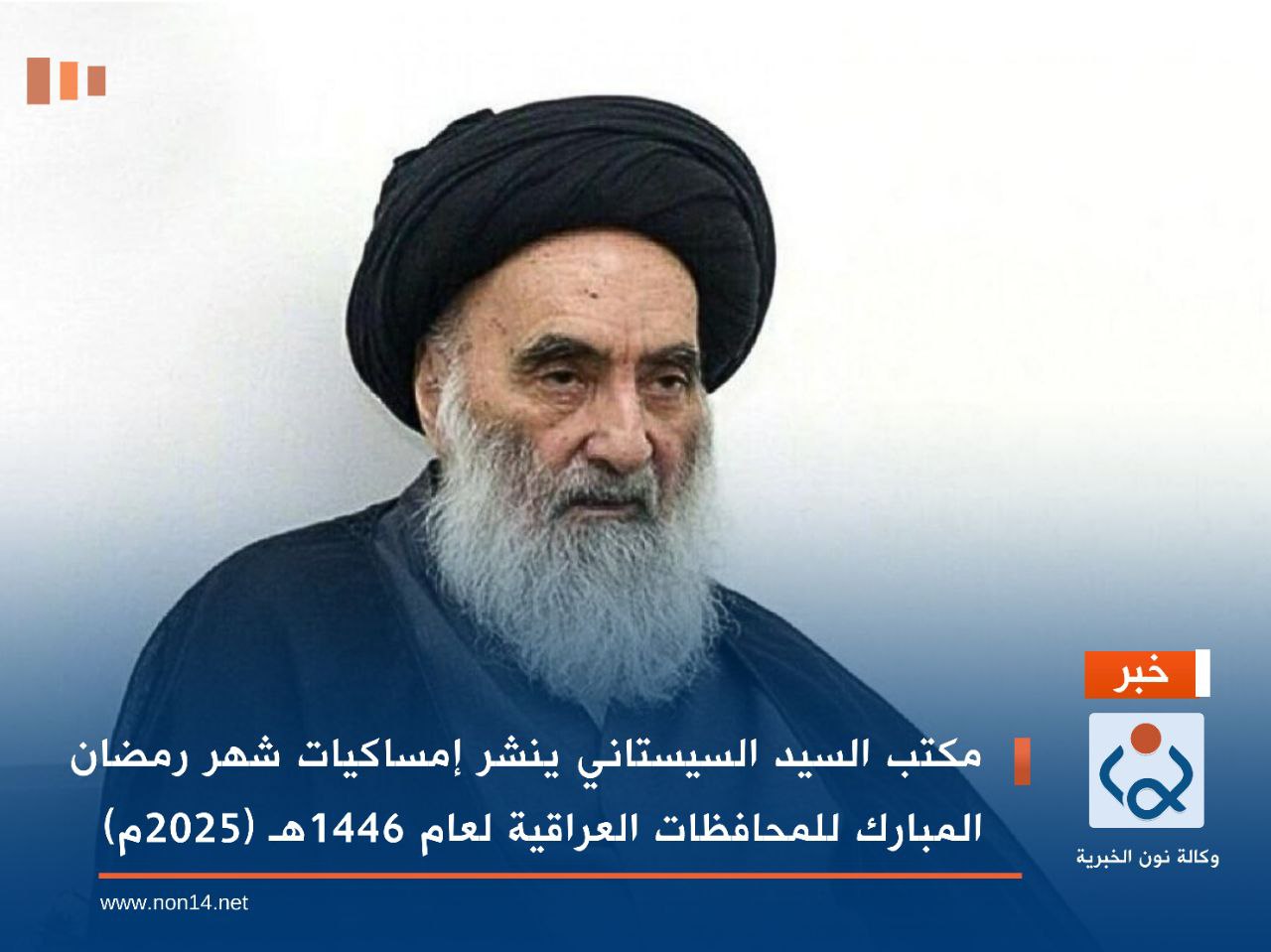




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!