بقلم: محمد تحسين كوك قايا
في ظل تصاعد الغضب الشعبي، وتراجع الثقة بالأحزاب الحاكمة، واقتراب موعد الانتخابات، عاد سؤال جوهري إلى الواجهة: هل يمكن أن يفقد الشيعة موقعهم في السلطة في العراق؟ هذا التساؤل لا ينطلق من خطاب طائفي معادٍ، بل يعكس نقداً متصاعداً لأداء السلطة التي ارتبطت في الوعي العام بالأحزاب الشيعية، سواء ذات الخلفية الإسلامية أو المرتبطة بمحاور خارجية.
منذ 2003، تأسس النظام السياسي العراقي على قاعدة المحاصصة الطائفية، ما منح المكوّن الشيعي نفوذاً سياسياً واسعاً، حتى وإن شارك السنة والكرد في الحكومات. لكن هذا النفوذ لم يترجم إلى بناء دولة فاعلة، بل تحوّل إلى سلطة مشروخة، قائمة على التمثيل الشكلي، ومرتبطة بفشل الخدمات، وغياب العدالة، والفساد، وقمع الحريات.
وقد أدى هذا التماهي بين السلطة والهوية الشيعية إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي، حيث صار النقد السياسي موجهاً—عن قصد أو دونه—نحو الطائفة، ما يُعيد إنتاج الانقسام الطائفي تحت قشرة وطنية. هنا تكمن الخطورة: تحميل مكوّن اجتماعي كامل مسؤولية فشل سياسي يُقوّض فكرة الدولة الجامعة.
من الطائفة إلى الدولة: ولادة وعي شيعي مدني
بعد 2019، شهد العراق تحوّلاً مفصلياً مع انطلاق تظاهرات تشرين، التي شكّلت لحظة فارقة في الوعي السياسي، خاصة في المناطق ذات الغالبية الشيعية. الحراك التشريني لم يكن مجرد احتجاج على سوء الخدمات، بل لحظة رفض لبنية السلطة، ولقواها المهيمنة. حرق مقار أحزاب تقليدية كالدعوة، بدر، والعصائب، وحتى التيار الصدري، عبّر عن رفض شعبي لاحتكار التمثيل الشيعي من قبل هذه القوى.
القوى المدنية التي برزت في هذا السياق لا تنفي الهوية الشيعية، لكنها تسعى إلى إعادة تعريفها ضمن إطار الدولة، لا الطائفة. هذا التيار الجديد يؤمن بضرورة التمثيل السياسي، لكنه يريد تمثيلاً تقدّميًا، لا طائفياً، يقوم على المواطنة والكفاءة، لا المحاصصة والغلبة.
بروز خطاب وسطي داخل “البيت الشيعي”
بدأت ملامح تيار وسطي شيعي بالظهور، يسعى إلى تجاوز ثنائية “الطائفة مقابل الدولة”، ويوازن بين الهوية المذهبية والانتماء الوطني. هذا التيار لا يعادي المرجعيات الدينية، لكنه يرفض تسييس الدين واحتكار السلاح خارج الدولة.
أبرز ممثلي هذا الخط السياسي كانوا:
حيدر العبادي: القادم من حزب الدعوة، حاول بناء خطاب وطني، خاصة خلال حرب الموصل، لكنه واجه ضغوطاً من داخل البيت الشيعي نفسه.
مصطفى الكاظمي: شخصية غير حزبية، اتخذ مواقف مدنية متوازنة، وسعى لترسيخ سيادة الدولة، ما جعله هدفاً لهجمات من قبل القوى الشيعية المسلحة.
محمد شياع السوداني: رغم انطلاقه من داخل “الإطار التنسيقي”، يحاول تقديم نفسه كرجل دولة، يوازن بين الولاء السياسي والبعد الوطني، مع جهود لضبط العلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة.
ما يجمع هؤلاء القادة هو إدراكهم أن السلاح خارج الدولة يُقوّض فكرة الحكم الرشيد. فكما يؤكد تعريف ماكس فيبر، الدولة الحديثة هي من تحتكر العنف المشروع، وأي انتشار للسلاح الموازي يُفرّغ الدولة من معناها السيادي.
حتى بعض الشخصيات المحسوبة على الإسلام السياسي مثل عمار الحكيم أو فالح الفياض أبدت ميولاً نحو خطاب وسطي، يتحدث عن الوطنية والشراكة، مع إعادة ترتيب العلاقة بين العقيدة والمصلحة العامة.
من التمثيل الطائفي إلى الأغلبية السياسية
المشكلة في العراق ليست في أن يكون رئيس الوزراء شيعياً، بل في تحوّل هذا الموقع إلى “حصة مكوّن” لا تُمس، بغض النظر عن الأداء أو الاستحقاق الانتخابي. هذا المنطق يقوّض الديمقراطية، ويحصر تداول السلطة في قوالب مغلقة.
منذ 2003، تعايش العراق مع نظام “الديمقراطية التوافقية”، حيث تُشارك كل المكونات في الحكم، ما أدّى إلى شلل في اتخاذ القرار، وتحوّل البرلمان إلى مظلة لتقاسم النفوذ، لا مؤسسة رقابية وتشريعية. فلا وزير يُحاسَب، ولا قانون يُمرَّر دون توافق سياسي شامل، حتى بين الفرقاء.
ظهرت محاولات للخروج من هذا النموذج، أبرزها ما حدث بعد انتخابات 2021، حين سعى التيار الصدري مع شركائه إلى تشكيل “حكومة أغلبية سياسية”، تقابلها معارضة برلمانية واضحة. ورغم فشل التجربة بسبب الانسحاب الصدري والصدامات المسلحة، فإنها فتحت الباب لنقاش جدي حول ضرورة الانتقال من المحاصصة إلى التنافس السياسي.
هل يمكن للشيعة أن يخسروا الحكم؟
الواقع الانتخابي لا يدعم فكرة “خسارة الشيعة للحكم” على المستوى العددي. فالشيعة يمتلكون أغلبية عددية ثابتة بفعل الجغرافيا، حيث تنتج محافظاتهم الكبرى (كالبصرة، بابل، ذي قار، النجف، وغيرها) أكثر من 120 مقعداً برلمانياً، تضاف إليها حصة وازنة في بغداد والمحافظات المختلطة.
لكن هذه الأغلبية لا تترجم تلقائياً إلى سيطرة موحدة، بسبب الانقسام داخل البيت الشيعي نفسه. لذا فإن الانتقال إلى “حكومة تحالف” لا يعني إقصاء مكوّن، بل تجاوز الصيغة الراهنة نحو نموذج توافقي برامجي، حيث تشكّل الحكومة بناء على برنامج سياسي مشترك، لا على تمثيل طائفي.
في هذا السياق، يصبح النقاش الحقيقي ليس حول “هل يفقد الشيعة رئاسة الوزراء؟”، بل: من يحق له تولّي المنصب في ظل معادلة ديمقراطية؟ الجواب: من يمتلك الأغلبية البرلمانية، ويستطيع تشكيل ائتلاف حكومي بغض النظر عن طائفته. فإن كان المرشح شيعياً فهذا بحكم التحالفات لا الطائفة، وإن كان من مكوّن آخر، فلا مانع طالما أنه يمثل كتلة منتخبة.
من الطائفة إلى الدولة: نحو سيادة مدنية
التحدي الأكبر لا يتمثل في الحفاظ على المواقع، بل في إعادة تشكيل من يتولاها. فالمطلوب ليس “سلطة شيعية” بالمعنى الطائفي، بل سلطة وطنية نابعة من بيئة شيعية، لكنها تعبّر عن مشروع وطني شامل. وهذا يعني بالضرورة فكّ الارتباط بين الهوية والسلاح، بين التمثيل الطائفي والولاء السياسي.
ما يحتاجه العراق ليس تغيير المكوّن الحاكم، بل تغيير طبيعة الحكم نفسه: من سلطة مغلقة قائمة على الامتيازات، إلى حكومة مدنية ديمقراطية تؤمن بالكفاءة، وتعمل ضمن مؤسسات دستورية. وهذا لا يعني “علمنة” السياسة الشيعية، بل “عقلنتها”، أي إخراجها من منطق المظلومية التاريخية وشرعية السلاح، ودفعها نحو مشروع دولة قانون ومواطنة.
خاتمة
العراق اليوم لا يعيش أزمة طائفية بقدر ما يواجه أزمة شرعية سياسية. والجواب على هذه الأزمة لا يكون بإقصاء أحد، بل بتجديد العقد السياسي، وتجاوز نظام المحاصصة، وبناء دولة مدنية تستوعب كل العراقيين كمواطنين، لا كطوائف متنازعة. مستقبل الشيعة في الحكم ليس مضموناً بحكم العُرف أو العدد، بل مرهون بقدرتهم على الانخراط في مشروع إصلاحي مدني، يعيد الاعتبار لفكرة الدولة الجامعة، لا السلطة المكوّناتية.















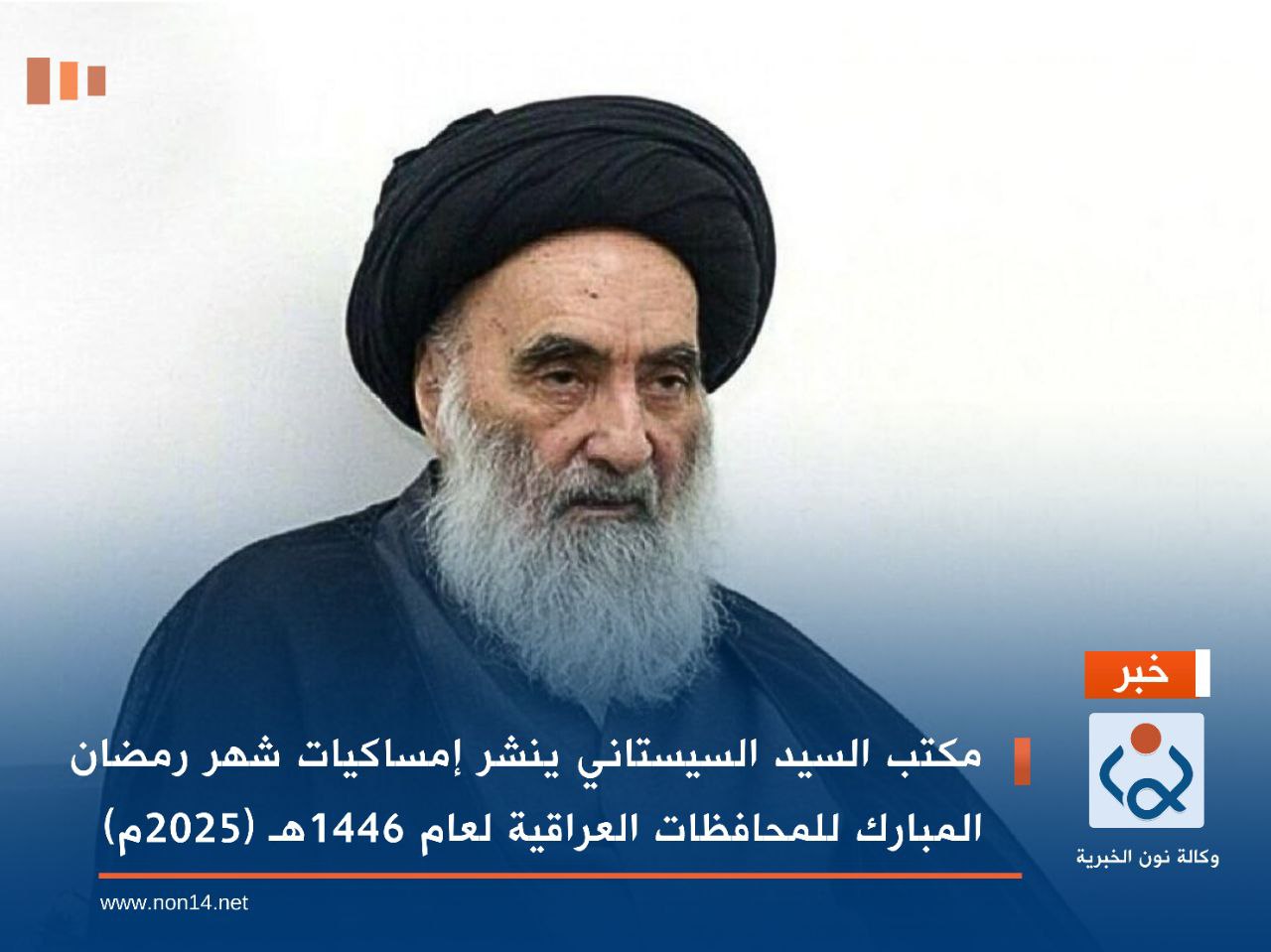




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!