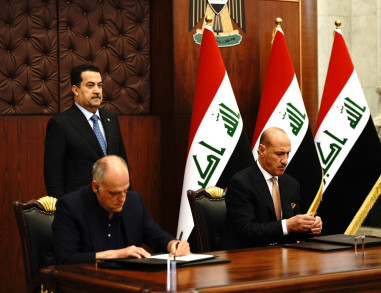- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
خيارات حكومة الكاظمي لاستعادة الدولة

بقلم: اياد العنبر
نميل في كثير من الأحيان إلى التلاعب بالمفاهيم، كمحاولة لتقليل قساوة الواقع، أو على الأقل حتى لا نتهم بالتشاؤم المفرَط. وفي العراق نكرر دائما كلمة "الدولة" مع إدراكنا بأن هذا الوصف حتى على مستوى المجاز يحتاج وقفةً وتأمل! ولذلك وطوال السنوات الماضية لم تغادر مفردة "بناء الدولة" برامج الحكومات ولا خطاب الطبقة السياسية، وعلى الرغم من ذلك لم نتلمس بعد ملامح مشروع حقيقي، لا للدولة ولا لبنائها.
في الآونة الأخيرة، باتت تترد عبارة "استعادة الدولة" باعتبارها المهمة الرئيسة لحكومة الكاظمي، وتبدو المغالطة الواضحة في هذا المفهوم؛ فدولتنا مفقودة من الأساس وليست مستلبة الإرادة، أولا، وقوى اللادولة هي الفاعل الأقوى في تحديد من يصل إلى سدة الحكم أو لا يصل.
يعبر مفهوم استعادة الدولة عن معنيين متناقضين: الأول يتضمنه إدراك الطبقة السياسية ويدور حول حماية مقراتها الحزبية التي تعرضت إلى الحرق والتجريف في المحافظات الوسطى والجنوبية بعد انطلاق تظاهرات أكتوبر، ومن ثم حديثها عن فرض القانون والنظام هو ليس لغاية فرض هيبة الدولة، وإنما لتأمين مناطق نفوذهم في مواسم الانتخابات التي باتت وجودها يختصر على قطاعات معينة من الجمهور يرتبط بها مصلحيا أكثر من ارتباطه بأيديولوجيتها وبرامجها السياسية، إن وجدت أصلا.
أما الإدراك الثاني لمفهوم استعادة الدولة، فهو مفهوم المواطن الذي يبحث عن دولة توفر له الأمن والأمان وتؤمن له سبيل العيش بكرامة، ويشعر فيها الأفراد بأنهم مواطنون من دون عناوين طائفية أو قومية تتعامل معهم أحزاب السلطة باعتبارهم أرقاما انتخابية. والمحور الرئيس في إدراك المواطن لمفهوم استعادة الدولة، هو حصر السلاح بيد الدولة، وأن يشعر بأن الدولة هي من تتكفل بحمايته من الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون.
وبين الإدراكين المتناقضين، لا توجد ملامح واضحة لمشروع استعادة الدولة في حكومة الكاظمي. فأمامنا تسعة أشهر تفصل عن الموعد الذي حددته الحكومة للانتخابات المبكرة، ولا يمكن أن نتصور أي تغيير تحدثه الانتخابات من دون أن يكون ثمة ضبط للأوضاع الأمنية التي يجب توفرها لضمان التنافس العادل في الانتخابات. إذ كيف يمكن أن تتخيل المنافسة بين قوى تملك المال والسلاح وتحاول توظيفه للبقاء في السلطة، وبين تجمعات شبابية لا تملك غير لافتات ترفع عليها شعارات تطالب بإصلاح النظام وتتحشد في الشوارع لإيصال صوتها المطالب بالحقوق والحريات في نظام يدعي أنه ديمقراطي.
معضلة الكاظمي وفريقه الحكومي تكمن في محدودية الخيارات المتاحة، فهي تنحصر في خيارين لا ثالث لهما: إما ترسيخ ركائز استعادة الدولة من الجماعات والأحزاب والشخصيات التي تمارس السياسة بمنطق المافيات، ورسخت ممارسات وسلوكيات قائمة على مصادرة الدولة ومؤسساتها وحصرها بإرادة زعامات الطبقة السياسية وحاشيتها؛ أو الإبقاء على الوضع الراهن من دون تغيير على مستوى نمط إدارة الدولة ومؤسساتها، ولكن تكون المواجهة على مستوى الإعلام والتصعيد في خطابات التهديد والوعيد والاستعراضات في المواقف ما بين الحكومة وقوى اللادولة التي تفرض سيطرتها على الواقع السياسي والاقتصادي بقوة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة.
ومن خلال تقييم حكومة الكاظمي منذ منحها الثقة لحد الآن، يمكن القول إنها تتبنى الخيار الثاني الذي يسعى لإبقاء الوضع على ما هو عليه وتكون المواجهة بالتصعيد الإعلامي. ويبدو أن هذه اللعبة ترضي الفريق الحكومي وقوى اللادولة، لأنها بالنتيجة لن يكون هنالك طرف خاسر وآخر رابح.
وبكل صراحة معركة استعادة الدولة أكبر حجما من قدرات الكاظمي وفريقه الحكومي، إذ أن تراكمات الفشل وسوء الإدارة والفساد قد أنتجت مأزقا سياسيا يهدد الدولة وكيانها وينعكس في توسع طبقة سياسية تسيّرها شهوة النفوذ والوجاهة، وتعتاش بطريقة طفيلية على تقاسم موارد الاقتصاد الريعي.
بيد أن الخطوات الصحيحة التي تعيد الاعتبار للدولة ولمؤسساتها ليس بالمهمة المستحيلة، لكنها تحتاج توفر عاملين أساسيين: الأول، التعاطي مع الأحداث السياسية وفق رؤية نموذج القائد الذي يسعى نحو بناء الدولة، وليس السياسي الذي يبحث عن مكاسب لترسيخ بقائه في السلطة. أما الثاني فهو الركون إلى مطالب الجمهور والرهان على استعادة ثقته من خلال تحقيق المنجز السياسي والاقتصادي والخدمي الذي يكون ملموسا لدى المواطن وليس الجولات واللقاءات الاستعراضية في الإعلام.
إذا أسلمنا بأن لدينا دولة ولكنها مخطوفة من قبل القوى والجماعات وأصحاب النفوذ السياسي والعسكري، فإن استعادتها تتم من خلال طريقين لا ثالث لهما: الأمن والاقتصاد.
فالأمن في العراق تتنازعه الجماعات الموازية للدولة، ولم يعد حكرا من وظائف ومهام مؤسسات الدولة. ومعادلة الأمن في العراق خطيرة جدا، فكلما بقي بوضعه الهش الذي يعبر فيه عن شلل النظام السياسي وفقدان لسيادة الدولة ومركزيتها وعجزها، يكون بيئة حاضنة وخصبة لقوى اللادولة في إثبات قوتها وفاعليتها وعلوّها على الدولة ومؤسساتها الأمنية.
والخطورة الأكبر على النظام السياسي طبيعة الإدارة الهجينة للمؤسسات الأمنية التي تتقاسم قوى سياسية تملك مليشيات وعناوين عسكرية رسمية. ومن ثم، لا يمكن أن تتمتع أي دعوة لاستعادة الدولة بمشروعية والثقة لدى المواطن ما لم يكن هناك مشروع حكومي لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وتشكيلاتها.
أما الطريق الثاني لاستعادة الدولة فيجب أن يكون عن طريق الاقتصاد، فالاقتصاد الريعي في بلد تصدر قوائم البلدان الفاشلة بالتأكيد لن يكون اقتصادا حقيقا يقوم على أساس إدارة الموارد وفق نظام اقتصادي حقيقي، بل هو اقتصاد تتنازع عليه وتتقاسمه مافيات مرتبطة بأحزاب سياسية. وإذا لم تكن هناك خطوات حاسمة لفك الارتباط بين هيمنة المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية على موارد الدولة ومنافذها الاقتصادية، فالنتيجة تكون تصريحات وخطابات الحكومة للتسويق الإعلامي وليس خطوات ضمن رؤية ومشروع لاستعادة الدولة.
الدولة أولا وأخيرا تملك جميع المقومات والمؤهلات التي يمكنها من خلالها استعادة هيبتها وسيادتها، ولكن ذلك لن يتم من دون إرادة قادتها، ومن ثم تخاذل من يتصدى للقيادة والحكم هو السبب الرئيس في ضعف الدولة وهشاشتها. والدولة تكون قوية بعلاقتها الوثيقة مع مواطنيها، وتكون فاشلة عندما تمسي محكومة بالصفقات والتوافقات بين زعماء الطبقة السياسية.
أقرأ ايضاً
- السيستاني و شرعية الدولة الدستورية
- كرم الحكومة
- لماذا أدعو إلى إصلاح التعليم العالي؟ ..اصلاح التعليم العالي الطريق السليم لاصلاح الدولة