بقلم: علي إبراهيم الياسري
لم يكن في حوزة العراقيين قبل 2003 كاميرا تسجلُ مقاطع الذاكرة المرة التي كانوا جزءاً منها، ولا كان لهم صوت يجهر بقسوة الحقيقة التي هشّمت حيواتهم، ما كان رأيا حتى يكون هنالك رأي آخر، ومع ذلك، كانت لهم ذاكرة، لكنها ذاكرة بلا إعلام، ذاكرة قلوب وجِلة، أتاحت بعد رفع ستارة الخوف للجيل اللاحق، معرفة قصة الماضي بتفاصيلها.
بعد 2003، ومع بزوغ القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، انقلبت أشياء كثيرة، منها الخوف الذي غدا لا يخيف أحدا، والموت الذي صار له أعوان ومناصرون وشعبية، ومنها أن التورّم الإعلامي رافقه فقدان مفاجئ في الذاكرة، حتى صارت الكتابة والكلمات والصرخات طريقة الناس للنسيان.
فلا تعني سبايكر الآن سوى مقطع فيديو لملثمين.. ولا مجال أصلا لإعادة النظر في سجل السيارات المفخخة والظروف الداخلية والإقليمية التي جعلتها عادة الصباح والمساء، وربما نسى عراقيون أحلام وآمال عمر سعدون، ولا سبيل بالتأكيد عند كثيرين لإعادة النظر بالسياسيين الذين هدموا حبّ الحياة في قلوب البسطاء.
لا حاجة لأن تستخدم الكلمات العالية، يكفي أن تشاهد برنامجا سياسيا ساخرا، أو منشورا واطئ الكلفة لتنفس عن غضبك، لتقتله، ثم ماذا؟ إنه معنى أن تعلم كل شيء، لا لشيء، إلا لتنسى!
ضئيلة هي الأعمال الفنية والأدبية والصحفية، التي وثقت بشكل منهجي، مأساة العراقيين الحديثة والمعاصرة بأسلوب يؤسس ذاكرة اجتماعية، حتى إنك لتفزع من فكرة أنك لن تكون قادراً، بعد سنين، على رواية ما جرى.
ولو قارنت الطريقة التي تعامل بها الغرب مع مآسيه الكبرى، بطرائقنا، ستعرفُ الفوارق، لكني أتخيّل طفلاً لا يعرف الكتابة، يكتبُ الآن: "وإن موّه الجاني الأدلة، وإن ركّب الكاتم فوق صدر الكلمات، سيبقى شريط الذاكرة المركون فوق الرف، أملاً قائما لاستعادة الحياة".














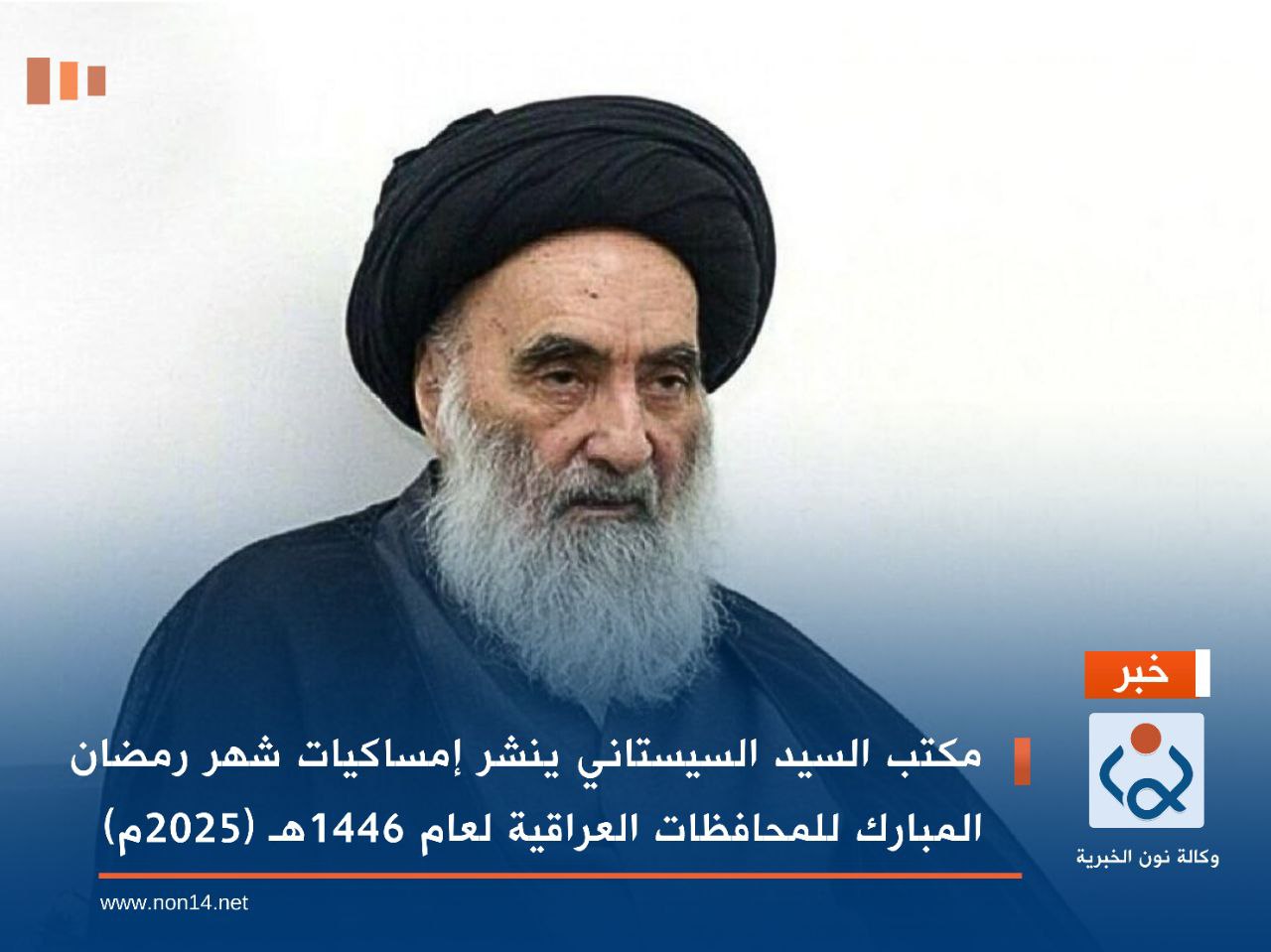




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!