بقلم: ابراهيم العبادي
(لن أتوافق معكم)، بهذه العبارة الصريحة قضى زعيم التيار الصدري على الفرصة الأخيرة للاتفاق (الشيعي - الشيعي) لتكوين الكتلة الأكثر عددا والمضي نحو استكمال الخطوات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة لمنصب رئيس الوزراء.
لم يتأخر جواب الإطار التنسيقي على موقف السيد مقتدى الصدر الرافض للتوافق والداعي الى أن يمضي أحد الفريقين الشيعيين في نسج تحالفاته وتشكيل قوام السلطات من دون الفريق الآخر، فقد كرر الإطار الدعوة الى التفاهم والتأكيد على أن العملية السياسية في العراق بنيت على التوافق، ولا بد من الالتزام بهذه القاعدة حتى النهاية.
فكرة التوافق هذه صارت حجر الزاوية في البناء السياسي العراقي، من يريد كسرها لا بد أن يوجد بديلا عنها، والبديل المطروح هو الأغلبية الوطنية العابرة للطوائف والمكونات.
حسنا ما هو عيب التوافق الذي صار مرفوضا اليوم؟، التوافق في الأصل أنموذج من نماذج الديمقراطيات التي صممت للاستجابة لمخاوف وتطلعات وطموحات القوى السياسية التي تعبر عن انتماءات ومصالح مكونات وجماعات قومية وأثنية وطائفية.
لم يدر بخلد ايكهارت ارندت وهو (يخترع) هذا الأنموذج لفترة انتقالية، أن تصبح التوافقية صيغة دائمة للحكم في بلدان التنوع الخارجة من حروب أهلية واستبداد عنيف، كان الهدف من اللجوء الى هذه الصيغة هو طمأنة النفوس وتهدئة المخاوف واقتسام السلطات والمشاركة في صنع السياسات بحيث لا يشعر مكون او جماعة أثنية بالغبن السياسي ويعيش مشكلة التهميش وهما أو حقيقة.
حينما يستمر التوافق لفترة انتقالية بطريقة حسنة ولا تعود السياسات مجحفة وغير عادلة ومحاباتية، حينها تتشابك المصالح وتغدو القوانين والإجراءات وخطط التنمية مقبولة، وتختفي من الثقافة السياسية شكاوى المظلوميَّة وانعدام المساواة.
التوافقية العراقية كسرت هذا المسار المفترض، فحتى الساعة لم تستقر العلاقات بين المكونات على قاعدة العدالة والمصلحة المتبادلة، ولم يقتنع ممثلو المكونات بأنّ مهمتهم الرئيسة بناء الدولة والخروج من حالة التأزم المستمر، فكل فريق يناضل سياسيّا ويناور إعلاميّا ويجتهد برلمانيّا لتأتي التشريعات والقوانين والموازنات على شكل مكافآت ومصلحة إضافية لفريقه، صحيح أنّ الدولة العراقية تحتاج إلى سنين طوال لتعالج مشكلات قديمة وحديثة، لكن التشابك في المصالح والمنفعة المتبادلة والتعامل وفق منطق الدولة للجميع لم تتحقق في أذهان القوى السياسية التي تدير السلطات، فضلا عن الجمهور العام، ولذلك يحتاج العراقيون وفق قاعدة التوافق هذه الى التراضي اليومي على كل قضية أمنية او سياسية او تنموية او تشريعية، والتراضي العراقي لا يشمل السياسات والقضايا الكبرى بل اقتسام الدولة والسلطات والمناصب الى مستوى مدير قسم، حتى بات الأمر عرفا يتحجج به السياسيون، فكل مختلف عليه لا يتم الاتفاق بشأنه إلا بمقولة التوافق، وأن الدولة لا تدار بالمغالبة بل بالتوافق، فصارت التوافقية استنزافية مدمّرة ومعطّلة ومشرعنة لكل أنواع التخلّف الإداري والقانوني.
الآن بات التوافق وكسر التوافق إلى فضاءات الأغلبية مصادرة على المطلوب، فالذين يصرون على التوافق يضعون المقولة المضادة (كسر الإرادات) ويعتبرونها خروجا على مصالح المكون وحقوقه الثابتة، والرافضون للتوافق داخل المكون الواحد مضطرون الى التوافق مع الآخرين من خارج المكون لتشكيل أغلبيتهم، وهذه الأغلبية تحتاج الى تفاهمات وتوافقات مرحليّة وآنيّة لكي تنتظم فيها مصالح الجميع، فاذا كنت قادرا على التوافق مع الآخرين فلِمَ لا تتوافق مع الفريق الذي يُشاركك الانتماء الى المكون؟، واذا أصبحت المهمة الوطنية كسر المحاصصات التوافقية التي نخرت الدولة وأفسدت سلطاتها، فهل يمكن استرضاء المصرّين على المحاصصة والتوافق على قضايا كبيرة وخطيرة من قبيل علاقة الإقليم بالمركز وصلاحيات عقد الاتفاقات والاستئثار بعائدات النفط والغاز والمعادن التي هي ملك الشعب العراقي كما يقول الدستور.
الحقيقة الصارخة أن المكونات العراقية تعيش صراعا داخليا بين توجهات وتيارات ايديولوجية وفكرية وبنيوية، يرى كلٌّ منها أن وجوده ومصلحته متحقق فيها، وأن هذه التوجهات تتقاطع في مفاهيم أساسية كالوطنية والاستقلال والوحدة الترابية والسيادة والكفاءة والعدالة والمواطنة.
الصراع الآن هو صراع شيعي - شيعي، وكردي- كردي، وسني - سني، لدينا صراع أجيال وصراع أيديولوجيات وأفكار وصراع مصالح وتبعيات الى الخارج، وما لم تحسم هذه الصراعات الداخلية لن يتوافق ممثلو الطوائف والمكونات على القاسم المشترك، وقد قادت هذه الصراعات القوى المختلفة الى تشكيل تحالفات لضمان وجودها والمحافظة على حيزها في المشهد السياسي، التوافق المرفوض والمطلوب في الآن ذاته، لا يمكن تجاوزه إلا بنضج سياسي وحكمة لدى الفاعلين تتخطى حسابات ومخاوف شخصية، وهذه تستغرق وقتا طال انتظاره، أو تأتي قوة من خارج المتخاصمين لتكون حكما وضاغطا وضامنا رغم كل المحاذير المترتبة على ذلك، أو يستمر هذا التعطيل فتفوت مصالح الناس وندخل في المرحلة الأكثر خطورة، إذ لا ثقة في الانتخابات ولا جدوى من إعادتها، فالمشكلة قائمة في تعادل القوى حتى يتغلب فريق على آخر، في الدول الديمقراطية يصار إلى إعادة الانتخابات، وفي الدول غير الديمقراطية يكون الحل وفق منطق القوة.
الآن فهمنا لماذا أمضى الفقه السلطاني إمامة المتغلب الذي يقهر منافسيه بقوة الشوكة ؟؟؟.














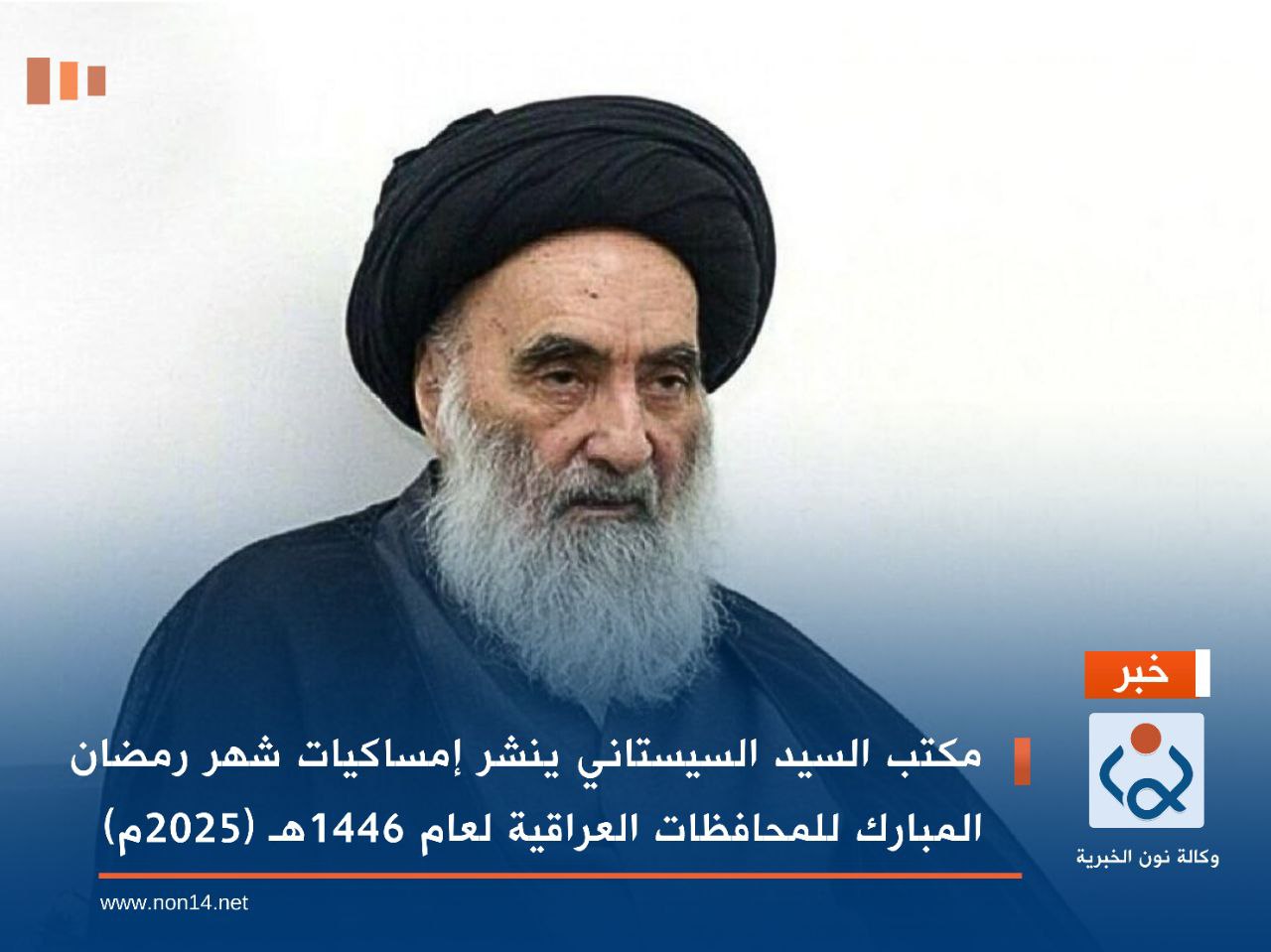




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!