بقلم: حسين فرحان
الدعاء يصعد إلى السماء، لا الرصاص.. والغيث ينزل منها، لا الرصاص..
يد تضغط على الزناد، فتفرغ ما في جعبة هذا السلاح (الروسي) الملازم لحياتنا منذ عقود طويلة في أجواء نحلم بان تخلو يوما من الرصاصة التي أصبحت سببا من الأسباب المتعددة لموت غير مبرر، وفراق مؤلم يخيم فيه اليتم والثكل على البيوت الآمنة، دون رغبة من القتيل بأن يرحل كغيره ممن اختار أن يقتل على الجبهات شهيدا لتحيا بموته مقدساته.
إن أدنى وصف لهذا القاتل أنه مستهتر، وأنه رهن اعتقال عقليته المريضة الاستعراضية العابثة التي لا ترعوي بنصح ولا تتعظ بمآلات حوادث سابقة أحدثها آخر قبله فجعلت منه ميت القلب والضمير.
هل سألنا أنفسنا ذات يوم عن أصل هذه الظاهرة؟ هل بحثنا في أسباب نشأتها؟ ولماذا أظهرنا عجزنا - كمجتمع- عن التخلص منها؟
هل هي مسؤوليتنا ام مسؤولية الدولة؟ وهل يمكن تجاوزها على المدى المنظور؟
سنستعين بذاكرتنا بعض الشيء.. ونرجع بها إلى ما تدخر من صور متناثرة لبعض الاحداث في سنوات مضت دون جعلها من التبريرات ولكن للاستشهاد بها واعتبارها من أسباب تفشي هذه الظاهرة.
أتذكر أن نظاما بعثيا عمل قبل عقود -إبان حكمه- على عسكرة المجتمع بطريقة تشبه إلى حد كبير تجربة بعض الدول التي كانت اطرافا مؤثرة في الحروب العالمية..، فالعقيدة العسكرية لمثل هذه الأنظمة كانت تقتضي عسكرة المجتمعات، ومن ثم زجها في الحرب لتحقيق مآرب أنظمتها الحاكمة، وبما أن النظام البعثي كان من الأنظمة التي تسعى لغايات معينة في بسط الهيمنة والنفوذ وتحقيق الأجندات الخارجية، فقد كانت عسكرة المجتمع العراقي تشكل لديه ضرورة قصوى ووسيلة مهمة لذلك، فكان مما قام به تشكيل فرق الأشبال والطلائع والفتوة وهي تشكيلات كانت ترتدي أزياء شبه رسمية وبألوان موحدة مع أغطية للرأس تعطي لطلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية هيئة عسكرية، وتمارس بهذه التشكيلات الاستعراضات وتزج في معسكرات تدرب فيها على استخدام سلاح ( الكلاشنكوف) والرمي بالرصاص الحي.
بالإضافة الى هذه التشكيلات فقد كان لطلبة المعاهد والكليات ومن كلا الجنسين نصيب في المشاركة بتشكيلات الجيش الشعبي الذي كان بالنسبة للنظام يعد ظهيرا للقوات المسلحة النظامية بشقيها التطوعي والإلزامي.
لم تكن المؤسسة العسكرية العراقية الرسمية هي الجهة الوحيدة التي توكل إليها المهام الحربية، مع وجود جهات أخرى كثيرة قسم منها مرتبط بالحزب الحاكم، وأقسام أخرى مرتبطة برئاسات اركان أخرى غير رئاسة أركان الجيش، لذلك كنا لا نرى سوى الطابع العسكري وهو يطغى على جوانب الحياة الأخرى، .. أما الممارسات العسكرية فقد كانت تعد إعدادا مدروسا وقد تم التخطيط له مسبقا في منهج ذلك النظام حيث كانت مراسم رفع العلم العراقي في جميع المدارس وبمختلف المراحل الدراسية لا تخلو -صباح كل يوم خميس- من إطلاق العيارات النارية وسط تجمع طوابير الطلبة، التي كانت تستنشق رائحة البارود وتستمع لصوت هذه الإطلاقات وتنظر للظروف الفارغة التي كانت تسقط عند أقدامها ومن ثم الانشغال بجمعها والاحتفاظ بها في المنزل واللعب بها.
في مشهد آخر كان تشييع الجنائز هو الآخر مشهد لم يخل يوما من هذه الطقوس، فكان إطلاق العيارات النارية يطغى على آداب التشييع وماينبغي أن يكون الأنسان عليه في أثنائه من سكينة ووقار وذكر واستغفار ودعاء لهذا المحمول فوق الأكتاف وهو مما أصبح من أعراف البعض الى يومنا هذا.
أما الحرب فهي وإن كانت واقعا مفروضا على من خاض غمارها بصفة مقاتل، لكن تأثيرها على عموم الشعب كان كبيرا لدرجة خلق معها هذا النمط من الناس الذي يجد متعته في كل ماينتمي للحرب والقتال، فتراه يبحث عن الفرصة المؤاتية لاستخدام ( السلاح الرشاش أو المسدس) في حفل عرس او تشييع جنازة او ( دكة عشائرية) أو فوز فريق رياضي أو حتى ختان طفل!
لغاية سقوط النظام البعثي كان العراق قد خرج من ثلاثة حروب، وكانت تجربة مجتمعه مع السلاح تجربة طويلة لازمته لعقود من الزمن، ومع دخول قوات الاحتلال وانهيار المؤسسة العسكرية كانت أسلحة أقوى جيش في المنطقة تملأ اسواق المدن وتباع كأية سلعة أخرى، ومع الشغف بالسلاح تسربت مخازن الجيش للبيوت لتحل -وما زالت- كزائر مقيم لا يحمل معه إلا نذر الموت، ففي أي لحظة يقع خلاف مع الجار، أو في السوق، أو في مكان ما ليبدأ الاستعراض، وكأن حامل السلاح يتحين الفرصة لممارسة مهاراته، ولست أدري هل أن بعضهم سيكون بهذه الشجاعة والجرأة لو لم تكن لديه ( كلاشنكوف)؟ ربما نعم وربما لا.. فقد يكون لبعض الجبناء رأي آخر في الاختباء وراء هذه الرشقات الاستعراضية البلهاء.
القضية برمتها بحاجة إلى تهذيب، وينبغي أن نفرق بين منح المواطن الحق في امتلاك سلاح شخصي بمواصفات معينة وشروط خاصة يخضع فيها للرقابة الحكومية، وبين سلاح لا سلطة عليه ولا رقيب، يحمله كل من تلاعبت به انفعالاته، فهو إما من صنف ورثة التركات الثقيلة للحروب وآثارها، او من صنف المستعرضين للعنتريات، او هو طفل أدمن شراء الأسلحة البلاستيكية في الأعياد وله تجربة بفقأ العيون!
نحن بحاجة ماسة إلى أن نعيد النظر في هذه المأساة الكبرى التي لازمتنا، وأن نعيد النظر في روح السلام والتعايش والاحتكام في مناسباتنا إلى العقل وفي نزاعاتنا إلى القانون، نحن بحاجة إلى ان نتخلى عن الانطباعات التي خلفتها مشاهد الحروب والموت والدماء و (صور من المعركة) في ذاكرتنا، وأن نغادر هذه الفوضى العارمة التي اجتاحت أمننا واستقرارنا، نحن بحاجة إلى أن نطلقَ هذه الأسلحة ثلاثا لا رجعة فيها، وأذا اقتضت الضرورات الذود عن الحياض فينبغي أن نسير على منهج الدول الأخرى التي توكل ذلك الامر لقواتها المسلحة فلا تسمع صوت الرصاص إلا على الجبهات، أما المدن فينبغي أن تنعم بالهدوء، لينام الطفل بسلام ولا يقض مضجعه صوت رصاص يطلقه جبان من (ستارة) سطح داره لا من على السواتر.
ان هذا يذكرنا ب "أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان".















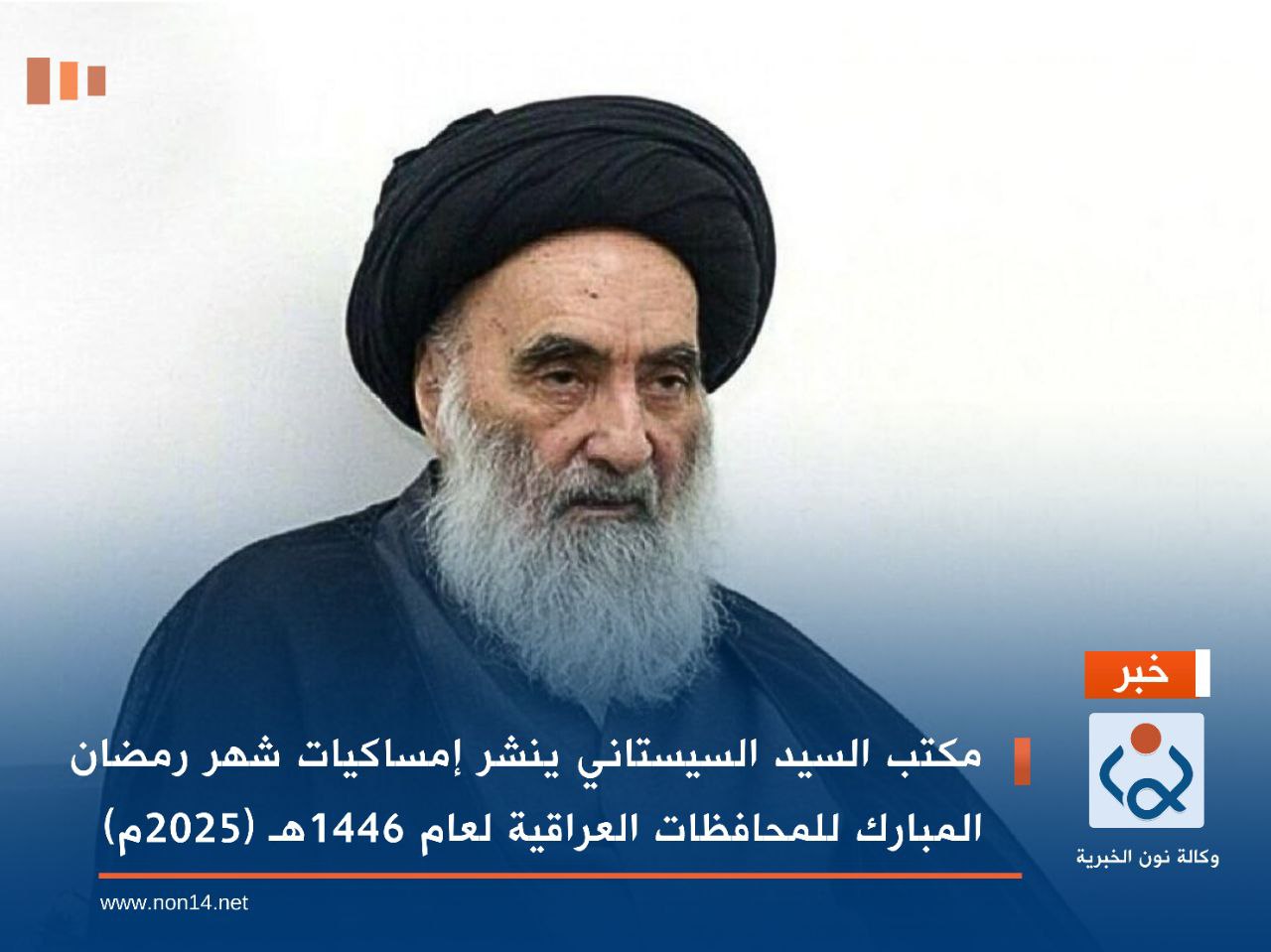




التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!