بقلم: د. خالد قنديل - سياسي وكاتب ومفكر مصري
لم تكن السيوف وحدها ما أنهى المعركة في كربلاء، كان هناك شيء آخر، خفي، لا تراه الجموع التي كانت تملأ الميدان وتهتف للنصر القريب، الذين كانوا في معسكر يزيد ظنوا أن الأمور حُسمت حين سقط جسد الإمام الحسين رضي الله عنه على التراب، وأن الخلافة قد أمنَت طريقها، وأن ما تبقى من الدم ستمحوه الشمس في اليوم التالي، لكن النصر، ذلك الذي لا يُقاس بعدد الجثث ولا بحجم الغنائم، كان قد تسلل من بين أقدامهم ومضى إلى جهة أخرى.
الإمام الحسين رضي الله عنه لم يكن يُقاتل ليبقى، بل كان يُقتل ليبقى، لم يُرد أن يسقط الطغيان بسيفه، بل أراد أن يفضح زيف النصر حين يكون على حساب الكرامة، فقالها بوضوح، بلا مواربة ولا خيال: "إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني". جملةٌ مثل هذه لا يتحدث بها قائد يسعى إلى سلطة، بل رجل يقدم روحه كحبرٍ يُكتب به التاريخ الحقيقي، لا الذي يكتبه المنتصرون، لقد انتصر يزيد يومها، كما انتصر كثيرون قبله وبعده، لكن من يتذكره اليوم إلا كظلٍ معتم؟، بينما بقي الإمام الحسين رضي الله عنه، قنديلًا مُضاءً في قلب الأمة، لا تنطفئ شعلته كلما حاول أحدهم دفن الذاكرة.
النصر، في كربلاء، لم يكن في عدد من بقي واقفًا في الميدان، كان في من بقي حيا في الضمير، والضمير، كما التاريخ حين يفيق من سُباته، لا يكذب طويلًا. أحيانًا، لا يكون الزلزال في لحظة اهتزاز الأرض، بل في الشقوق التي تتسرب بعدها، كربلاء كانت هذا الزلزال: ليست مجرد مذبحة، بل نكبة أخلاقية لحكمٍ ظن أن الجريمة تُمحى بالسكوت، يزيد جلس على العرش يوم العاشر من محرم منتصرًا، لكنه لم يكن يعلم أن الإمام الحسين رضي الله عنه، وهو صريع، قد زرع في صمت موته بذور السقوط التدريجي لكل ما مثله يزيد.
في ذلك اليوم، لم تُسقط السيوف رأس الإمام الحسين رضي الله عنه فقط، بل أسقطت القناع عن وجه الخلافة، فقد رأت الأمة بعد أن جفت الدماء صورة من كان يقول إنه ظل الله في الأرض، فإذا به يذبح ابن بنت نبيه، وأدركت الأمة، ولو بعد حين، أن السيف الذي سُحب على الإمام الحسين رضي الله عنه، قد رُفع في وجه كل من حاول أن يقول "لا" في حضرة السلطان.
من هنا، بدأ الشك يدخل بيت الطاعة، الناس الذين كانوا يُصدقون شعارات "الجهاد" و"الفتوحات" و"حماية الدين" بدأوا يتهامسون: أهذا هو الإسلام؟، أهذه هي الخلافة؟، أي جهاد هذا الذي يُطير رأس الإمام الحسين رضي الله عنه عن جسده ويُعلقه على رمح في شوارع الشام؟. وبعد أعوامٍ؛ لم يدم ذلك الهمس طويلاً، وقد خرج التوابون، بقلوب مكسورة وضمائر ثقيلة، لا يطلبون سلطة، لكنهم أرادوا أن يقولوا: "كُنا مخطئين"، ثم جاء المختار الثقفي، وجاءت الثورات العلوية، وجاء العباسيون على وعد الثأر للحسين، حتى وإن خانوه لاحقًا، فالإمام الحسين رضي الله عنه لم يكن شخصًا، بل مرآة، جعلت الناس يرون أنفسهم، ويرون الدولة من غير زينتها.
جسد الإمام الحسين رضي الله عنه سيُدفن، لكن صوته يجب أن يُبعث من جديد، هنا، لم تكن المسألة عاطفية، لم تكن السيدة السيدة زينب عليها السلام عليها السلام مجرد أخت فُجعت في أخيها وتئن لفقدها، بل شجرةُ الصبر الوارفة، ومظلة الأمل، واعية، مثقفة، متجذرة في مدرسة علي وفاطمة، تعرف أن الطغيان لا ينتصر بالقتل، بل بالنسيان، فحالت دون أن ينسى الناس تلك المذبحة، لا لاستدرار العبرات وتشييد البكائيات، وإنما لترسيخ الحق ووضع الضمائر على مؤشر العدل، حتى لا تندثر القيم في دوامة الخوف، ولا تُدفن الحقائق تحت ركام الصمت. السيدة زينب عليها السلام كانت الصوت الجهور في زمن الانكسار، رفعت رأسها لا لتتحدى قاتليها وحسب، بل لتُبقي ذاكرة الأجيال أن الدم لا يُهزم ولا يجف، بل يبقى نديًا راويًا أرض البصيرة.
رفعت السيدة زينب عليها السلام الكلمة، وفي زمنٍ لم يكن يُسمح فيه للنساء بالكلام، وقفت وحدها، وقالت ما لم يجرؤ عليه الرجال. في الكوفة، لم تُلقِ خطبة عزاء، بل محاكمة علنية: جعلت من الناس شهودًا على ما سمحوا بحدوثه، هزت ضمائرهم، حركت الصمت في قلوبهم، في الشام، لم تتكلم مع يزيد كأُسيرة، بل كند: جردته من شرعيته أمام الناس، وواجهته بلغة لم يفهمها جنده: لغة الموقف، والشرف، والاستقامة. "فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا".
كانت تعرف أنها تتكلم لا لتنتقم، بل لتبني جدارًا من الذاكرة، لا تقدر السلطة على هدمه، كل كلمة نطقتها لم تكن لأجل اللحظة، بل لأجل قرون ستأتي، وهذا ما حدث. لو لم تقف السيدة زينب عليها السلام، لربما تحولت كربلاء إلى هزيمة خافتة في صفحات المؤرخين الرسميين، لكنها، بصبرها، ببلاغتها، بإصرارها، أعادت تسمية الحدث: لم تعد كربلاء مذبحة، بل ثورة، لقد أعادت خلق الإمام الحسين رضي الله عنه حيا في وعي الأمة، رفعت ذكراه من التراب، وغرسَتْه في وجدان الناس، إلى يومنا هذا، السيدة زينب عليها السلام لم تكن أخت الإمام الحسين رضي الله عنه فقط، بل كانت امتداده، كانت بعبارة دقيقة ضمانة عدم نسيانه.
كربلاء كادت أن تُدفن في الصحراء، فقد انتهت المعركة، وسُبيت النساء، وسكتت السيوف، وارتفعت رايات النصر على أرض ملأى بالقتلى، وفي المنطق السياسي، انتهى كل شيء، لكن السيدة زينب عليها السلام، تلك التي مشت خلف الركب لا كجارية، بل كأرشيف حي، رفضت أن تترك الدم يُمحى بالرمل، فالمصيبة في كربلاء لم تكن فقط مذبحة، بل محاولة ممنهجة لمحو المعنى، ومن هنا بدأت حركتها.
كانت وحدها تحمل النسيج الداخلي للثورة، فالإمام الحسين رضي الله عنه قاتل بدمه، لكنها قاتلت بذاكرتها، هي من جمعت أشلاء الحكاية، وبدأت ترتبها، لا لتبكي عليها، بل لتعلمها، خطبها في الكوفة والشام لم تكن لحظات غضب عاطفي، بل مقدمات تأسيسية لوعيٍ حسيني جديد، من خلالها تحولت كربلاء من مجزرة منسية، إلى قضية تُروى، تُعاد، وتُبكى، وتُقرأ، وتُحيا، لقد فهمت السيدة زينب عليها السلام أن المأساة، ما لم تُروَ، فإنها تُنسى، وما يُنسى، يُعاد تكراره على يد الطغاة، مرة بعد مرة، لهذا، رفضت السيدة زينب عليها السلام أن تكون كربلاء مأتمًا فقط، حولتها إلى شعلة سرد، لا تخمد، كانت تروي من رأته يُذبح، لا من سمع عنه، كانت تفضح الجريمة، من موقع الناجية، لا من موقع المراقبة، وكانت تُربي عبر صبرها جيلًا كاملًا يفهم أن السكوت على القتل مشاركة فيه، وبذلك، فعلت ما لم يفعله المنتصرون: "أسست حركةً لا تنتهي"، تجاوزت بها زمان كربلاء، فصار الناس بعدها لا يحيون ذكرى موت، بل ينتمون إلى ثورة لا تزال مفتوحة منذ شرارتها الأولى، ثورة ألقت الرعب في قلب يزيد وأنصاره، فهابوها هيبة دفعتهم لنفيها، وهي المُعلّمة التي علمت الأمة أن الحزن، إن لم يتحول إلى وعي، يذبل، وأن الذكرى، إن لم تصبح موقفًا أخلاقيًا مستمرًا، تصبح طقسًا باردًا يُطفئ النار الأصلية، بهذا، حفظت السيدة زينب عليها السلام كربلاء من التجميد، جعلتها نموذجًا، لا قصة، وجعلت من وجعها الطويل منبرًا لكل من يريد أن يقول "لا" في كل زمان ومكان.
الذين ينظرون إلى السيدة زينب عليها السلام كما ينظرون إلى امرأة تبكي شهيدها، لم يعرفوها، والذين يتعاملون مع بطولتها كأنها رد فعل تلقائي على المصاب، لم يقرأوا جيدًا مدرسة بيت علي بن أبي طالب، السيدة زينب عليها السلام لم تكن تعيش في كربلاء لحظة مأساة فقط، بل كانت تحمل في داخلها نظرية كاملة للصبر، وللحق، وللمسؤولية، لقد هزها الألم، لكنها لم تهتز، كُسرت من الداخل، لكنها نهضت، لا لتشتكي، بل لتُربي الأمة من جديد.
لم تُربِ السيدة زينب عليها السلام أبناءها فقط، بل ربت الزمن بعد كربلاء، لقنت الكوفة درسًا في مواجهة الخنوع، من دون أن ترفع يدًا، وعلمت نساء الشام أن المرأة يمكنها أن تكون راعية ذاكرة، وحارسة معنى، ومعلمة صبر، كانت مصلحةً دون سلطان، ومربيةً دون مدارس، وقائدةً دون جيش، ومن ذلك الحيز الضيق الذي تتركه المصيبة عادةً للنساء ركن البيت، زاوية الدمع، صمت العزاء خرجت السيدة زينب عليها السلام، لا لتنقض النظام، بل لتفضحه دون أن تلمسه، أعادت للمفهوم الديني روحه، حين شوهه الطغاة، وأعادت للبطولة شكلها، حين تم تجويفها في أناشيد المنتصرين.
في الحسابات المادية، سقط الإمام الحسين رضي الله عنه، في لائحة القتلى، وُضع اسمه، في دفاتر يزيد، رُفعت الراية، وعاد الجنود، لكن في ذاكرة الذين بقوا في قلب كل من فكر قليلًا، وتأمل أكثر لم يسقط الإمام الحسين رضي الله عنه، بل سقط التاريخ الزائف، الإمام الحسين رضي الله عنه كان يعلم أنه يُقاد إلى الذبح، ومع ذلك مضى، والسيدة زينب عليها السلام كانت تعلم أن الأيام المقبلة ستكون أصعب من القتل، ومع ذلك تكلمت، ومنذ ذلك اليوم، بدأت فكرة جديدة تُولد في الأمة: أن الحق لا يحتاج إلى عدد، بل إلى صمود، ومنذ ذلك اليوم، بدأت الهزيمة تفقد معناها القديم، فما عاد من يبقى حيا هو المنتصر دائمًا، بل من يبقى حيا في الضمير، هو الذي لا يُهزم أبدًا.
الإمام الحسين رضي الله عنه صار مدرسة، لا سردًا، والسيدة زينب عليها السلام، تلك المرأة التي مشت بين الحرائق تمسك بيد الأطفال وتشد بيدها الأخرى حبال الحكاية كي لا تسقط، صارت الحارسة التي أنقذت الثورة من التحول إلى مجرد صفحة دامية في كتاب الطغاة.
لقد انتهت المعركة في كربلاء، لكن الحقيقة بدأت تسير بعدها..
تمشي حتى يومنا هذا..
وكلما توقفنا عندها وسألنا:
من الذي انهزم فعلًا؟
جاء الجواب، لا من السماء، ولا من كتب التاريخ، بل من داخلنا:
الذي ينسى كربلاء.. هو المهزوم.



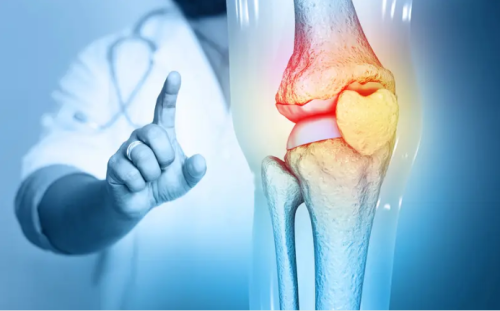













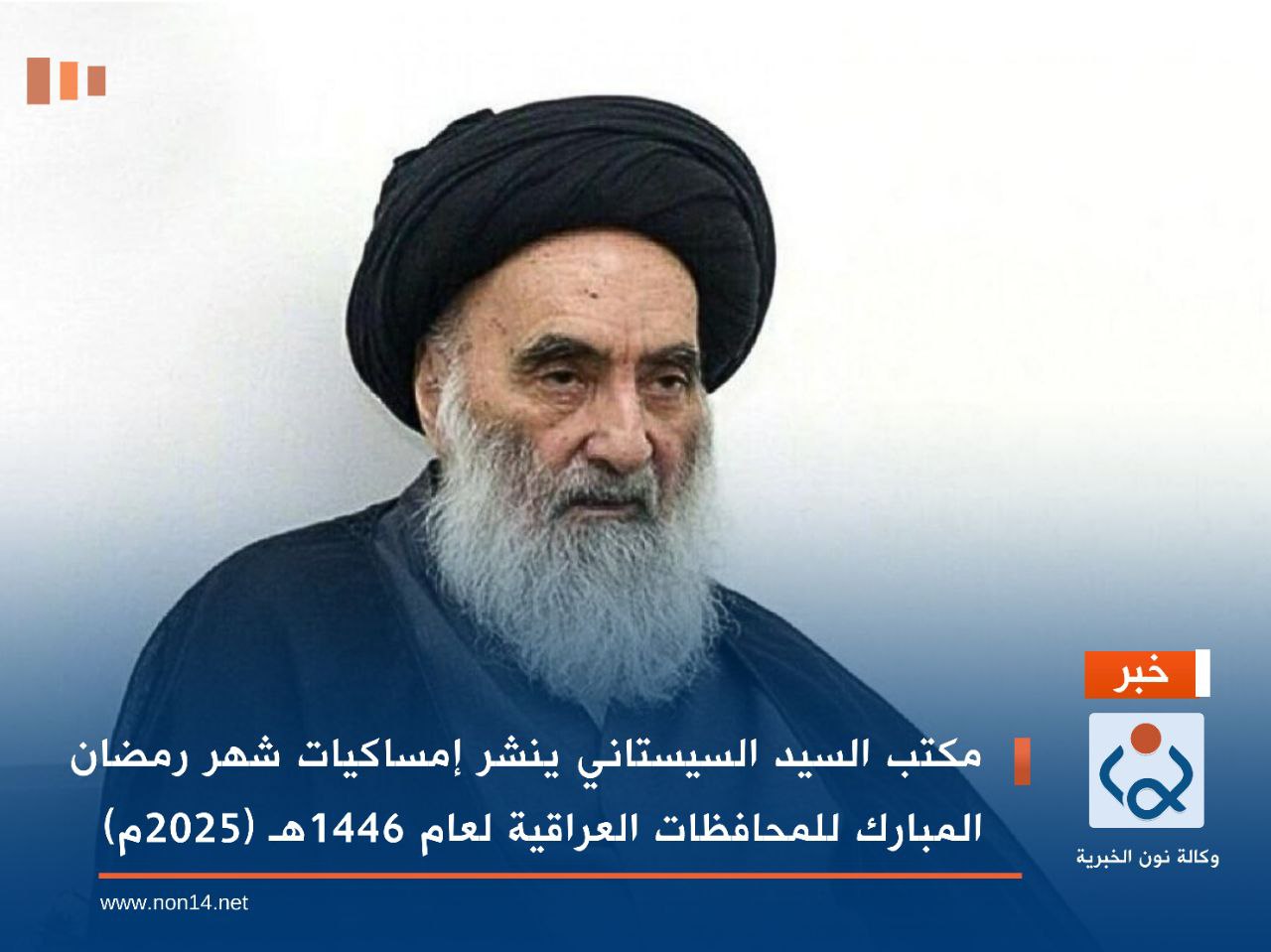




التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!