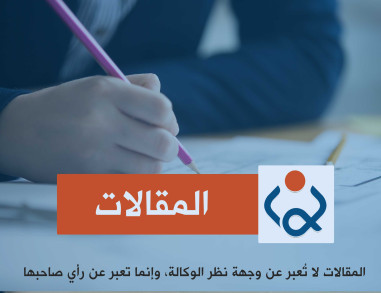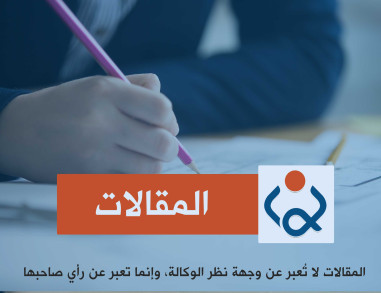- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
السنن الإلهية ودورها في التربية وفي فهم الواقع على ضوء القرآن الكريم

بقلم: علي الراضي الخفاجي
السُّنَّة في (اللغة): النهج، الطريقة، السيرة، مأخوذة من السَّنن: الطريق، الوجه، القصد.
ومن معانيها: القانون.
والسُّنن الإلهية (اصطلاحاً) تعني: إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، أوامره الشرعية، فعله المطلق، كلماته التامَّات، وعوده الحقَّة، وحكمه في آفاق الكون وتسلسل التاريخ الجارية بالعباد من المعاش إلى المعاد.
عنه صلى الله عليه وآله:(من سنَّ سنة حسنة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنَّ سنة حسنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
فالسنة هي الطريقة، يقول تعالى ((كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.لايؤمنون به وقد خلتْ سنة الأولين)). وسنة الأولين: يعني كانت سنة في الأولين هذه الطريقة، وهذه طريقة من سبقهم: إيمان ثم كفر وجحود ويتبعه عقاب.
والسنن تعني إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الانسان ويجعله خليفته في الأرض ويمنحه دوره دون أن تكون هناك سنن وقوانين، ويعني الوجود لايكون في فوضى.
وغياب فهم السنن أو عدم فقه السنن يؤدي إلى أن يكون طاغياً لايفكر في العتاقبة، فيقول((إنما أوتيته على علم)) أو فرعون يقول((أنا ربكم الأعلى فاعبدون)).
وغياب هذا الفهم يجعل الإنسان منظوره جزئي، فقد يستفيد من سنن المادة، فقد يغيب عنه ينة الهداية وسنة التأييد.
وبالتالي قد تؤدي إلى فقدان الإنسان إنسانيته وعلاقته بالإنسان الآخر، ويصبح فرداً مفصولاً حتى عن نفسه، فقد يستعيض بدمية قد صنعها تشبه الإنسان، أو بحيوان يعيش معه.
((نسوا الله فنسيهم)). كما قد ينزعج البعض عند تعليمه الآخرين وتوعيتهم فيواجه الرفض، وفهم السنن يجعلنا نستشرف المستقبل(قراءة المستقبل)، والتخطيط للمستقبل.
ويصح أن نسميها ثقافية سننية شاملة أو تربية سننية.
والسنن تكون في أربع ساحات:
- سنن الله في الآفاق
- سنن الله في الأنفس ((سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم..
- سنن الله في الهداية: التي جاء بها الوحي((فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلايضل ولايشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا..
- سنن الله في النصر والتأييد. غيبيات. ((أم حسبتم أن تدخوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب)) البقرة/214. ويقول تعالى((حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جآءهم نصرنا فنجي من نشآء ولايرد بأسنا عن القوم المجرمين)). يوسف/110.
والسُّنن الإلهية على نوعين:
الأول: هي السُّنن الحاكمة في الطبيعة، والتي تشمل الجانب المادي للكون ونظامه(تركيبه، مجرياته، حركته)، وهي أوسع نطاقاً، حيث تخضع لها جميع الكائنات الحية في وجودها المادي، وتعرف بسنن الكون أو الطبيعة أو الآفاق، وهي تتعلق بربوبيته تعالى، وفيها يظهر قدرته وتدبيره، يقول تعالى:((إنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناسَ وما أنزل الله من السمآء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السمآء والأرض لآيات لقوم يعقلون)) البقرة/ 164.
ويقول تعالى:((سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنَّهُ الحق))فصلت/53.
وهي سنن حتمية في طبيعتها، لكنها قابلة للخرق بمشيئته تعالى.
فهناك سنن منظورة وخاضعة للتجربة.
الثاني: هي السُّنن الحاكمة في الإنسان- إن كان فرداً أو جماعة أو أمة - باعتباره خليفة الله في الأرض، وتشمل علاقة الإنسان بالكون وخالقه وعلاقته بالآخر، وتسمى(السُّنن الاجتماعية أو الدينية أو الشرعية)، ودليلها نحو قوله تعالى:((ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربُّ العالمين)).
فالخلق: أفعاله، وما قضاه وقدَّره.(القضاء يعني الحكم والقَدَر يعني التوزيع أو الوقوع).
والأمر: دينه وما شرَّعه لخلقه.
وهذه السُّنن متحكمة في فكر الإنسان وسلوكه وحركته في المجتمع(تفاعله وممارسة دوره، وفاعليته في حركة التاريخ) ويريد سبحانه وتعالى بهذه السُّنن الارتقاء بالإنسان إلى المراتب العليا، وتدور الحكمة من وراء هذه السُّنن في مجال التربية والتكامل للإنسان.
ربانية السُّنن: تعني أن السُّنن التاريخية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وبهذا تكتسب الطابع الغيبي، فهي ليست بمعزل عن إرادته وقدرته، وهي حقيقة أكدت عليها الآيات القرآنية.
ولكن هذا الطابع لا يبعدها عن التفسير العلمي الموضوعي، مثلاً لو فسر إنسان بعض الظواهر الطبيعية كنزول المطر واختلاف الليل والنهار وكسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل وغيرها بأنها تحصل بإرادة الله سبحانه ويكتفي، فهي وإن كانت حاصلة بقدرته المطلقة، ولكنه قد يجعل من هذا التفسير بديلاً عن تناول الأسباب الطبيعية فيجرِّد الحوادث عن التفسير العلمي الموضوعي، ولو تحدث عن أسبابها الطبيعية وكيف أنه سبحانه أودع فيها الأسباب -وهو مسبب الأسباب- لحكمته وتدبيره للكون والحياة، ناظراً إلى السُّنن نظرة علمية وإيمانية مسبغاً عليها الطابع الرباني(الغيبي) فيصبح حينئذ مفسراً لها تفسيراً منصفاً على أساس(المنطق والعقل والعلم والإيمان) لا أنها مرتبطة بالغيب ومجردة عن أسبابها الطبيعية، ولا أنها مجردة من ذلك الارتباط كما يذهب إلى ذلك الدهريون أو الملحدون.
فالغيب من جهته إمداد، والأسباب الطبيعية قائمة في صنع الحوادث، وهي تخضع للمنطق والعلم.
يقول تعالى بخصوص الإمداد، والذي من مصاديقه النصر:((أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمَّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقولَ الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إنَّ نصر الله قريب))البقرة/ 214.
ويقول تعالى أيضاً:((إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مُمدُّكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنَّ به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إنَّ الله عزيزٌ حكيمٌ)) الأنفال/9-10.
وفي كل ذلك جرت الأقدار وفق أسبابها فتارة يكون هناك نصر وتارة هزيمة، والأقدار لاتستثني حتى الأصفياء من خلق الله سبحانه كالأنبياء والأوصياء والأولياء، كما أنَّ:((لكلِّ أمة أجلٌ)) و:((لكلِّ أجلٍ كتابٌ)).
وكلمة(سنن) في القرآن الكريم وردت في معرض الحديث عن السنن الاجتماعية، وأما سنن الكون فقد سماها سبحانه وتعالى(الآفاق أو الآيات) وارتباط السُّنن الكونية والاجتماعية يأتي من كونهما صادراً عنه سبحانه.
ولأنَّ السُّنن الاجتماعية مرتبطة بالتحولات والتطورات والحوادث والوقائع فقد أصبح لها بعدٌ تاريخيٌ وأثرٌ فاعلٌ في حركة التاريخ المؤثرة في المسيرة الإنسانية، لذا سميت بالسنن التاريخية.
أنواع السنن الإلهية، منها:
1- سنة المداولة، كما يقول تعالى((إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء..))آل عمران/140.
2-سنة التغيير، كما يقول تعالى((إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم))الرعد/11.
3-سنة التدافع، فيذهب سبحانه الظالمين ويأتي بالمحسنين، ويذهب بالكافرين ويأتي بالمؤمنين، وهكذا، يقول تعالى((..ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين))البقرة/251.
4-سنة النصر، يقول تعالى((إن تنصروا الله ينصركم))محمد/7، وقال((وكان حقاً علينا نصر المؤمنين))الروم/47، ولكن يسبقها سنة الابتلاء والتمحيص، يقول تعالى((أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين))العنكبوت/ 2-3.
5- سنة أخذ الظالمين وإهلاكهم((ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وماكانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين))يونس/13.
ولكن بعد أم يمليهم ويستدرجهم، كما يقول تعالى((ولايحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين))آل عمران/178، وقال((والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجُهُم من حيث لايعلمون وأملي لهم. إن كيدي متين))الأعراف/183.
أملي لهم: أمهلهم، يعني لاأعجلهم بالعقوبة. وهكذا مصير الدول والبلدان((وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير))الحج/48 أمليت لها: أخرجتها.
6-سنة الغلبة والتمكين للمؤمنين((وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها..))الأعراف/137.
7-سنة الاستبدال، حيث يذهب تعالى بقوم ويأتي بآخرين((وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم))محمد/38.
8-سنة التمييز والتمحيص((ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب))آل عمران/179.
9-سنة التسليط، ومنه تسليط الظالم على الظالم، ((وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون))الأنعام/129.
طبيعة السنن الإلهية
1-الثبات: فمن طبيعتها أنها لا تتبدل ولا تتحول.
وتبديل السنن: أن توضع النعمة والعافية موضع العذاب.
وتحويل السنن: أن ينقل العذاب من قوم يستحقونه إلى غيرهم.
2-العموم: أي أنها يخضع لها جميع البشر والخلائق دون استثناء، في أفعالهم وتصرفاتهم وسلوكهم في الحياة، ويترتب على ذلك حصول النصر أو الهزيمة، والسعادة أو الشقاء، والعز أو الذل، والرقي أو التخلف، والقوة أو الضعف، فكل من هذه وارد، بما فيهم الأنبياء والأوصياء والأولياء.
3-الاضطراد(التكرار): يقول تعالى((قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين)) آل عمران/137.
وينتج عن ذلك أمران:
1-استبعاد عنصر المصادفة المدعاة، إذ لايمكن للمصادفة أن تثبت نظاماً، أو تجعله شاملاً.
2-إعطاء العلم دوره لاكتشاف السنن الاجتماعية والتاريخية والحث على دراستها بشكل موضوعي.
هل النواميس الكونية تخترق؟
الأصل في السنن الكونية الجريان، ((لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون))يس/40، ولكن إذا شاء الله تعالى لحكمة تعطلت أو انعكست، فهي سنن إلهية تسير بالتسخير وليس بالاختيار، أي بطريقة القهر والتنجيز الآني، كما يقول تعالى:((ثم استوى إلى السمآء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتآ أتينا طائعين))فصلت/11، لا كما تقع في الأفراد والمجتمعات حيث تتعلق هذه السنن بأمره ونهيه ووعده ووعيده وما ابتلاهم به من الشرع لينظر كيف يعملون، ولأنَّ لله سبحانه القدرة المطلقة كما يقول تعالى)):إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون))النحل/40، وقال:((إنَّ الله على كل شيء قدير))البقرة/20، فهو قادر على أن يخرق السنن التي وضعها، ليظهر قدرته وجمال حكمته، كإظهار المعجزات على أيدي الأنبياء لإثبات نبواتهم، كما جعل نار نمرود المحرقة برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام عندما سلب منها طبيعة(الإحراق) يقول تعالى((قلنا يانار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم))الأنبياء/ 69، كما سلب خاصية السكين(القطع)عن عنق إسماعيل عليه السلام، حينما قال تعالى((فلمآ أسلما وتله للجبين.وناديناه أن يآإبراهيمُ.قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.إنَّ هذا لهو البلاء المبين.وفديناه بذبح عظيم))الصافات/103-109، وجعل عصا موسى عليه السلام حية تسعى ويده تخرج بيضاء من غير سوء كلما أدخلها في جيبه، قال تعالى((قال ألقها ياموسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولاتخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى))طه/19-22، وخلق عيسى عليه السلام بدون أب،((والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنهآ آية للعالمين))الأنبياء/91، ومد في عمر نوح عليه السلام، وفي عمر المهدي المنتظر عليه السلام، فحقيقة المعجزات أنها مخالفة للعادة، لـ(سنة الجريان)، وهي ليست مستحيلة عليه سبحانه، وعليه يمكن تقسيم السنن الإلهية إلى:(سنن جارية)و(سنن خارقة).
هل يمكن أن يغير الدعاء السنة الكونية؟
نعم، كدعاء امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها محرراً له سبحانه وتعالى، وطلبت منه القبول فرزقها مريم وخلق منها عيسى عليه السلام، ((إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك مافي بطني محرراً فتقبل مني إنك سميع الدعاء.فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت))آل عمران/35، ودعاء زكريا عليه السلام له سبحانه((هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء))آل عمران/38-40، فاستجاب له مع كبر سنه فحملت امرأته وهي عاقر لا قدرة لها على الإنجاب، فقال تعالى((فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه))الأنبياء/90، ودعاء نوح عليه السلام أن لايبقي أحداً من الكافرين على الأرض فاستجاب له، قال تعالى((ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم))الأنبياء/76، ودعاء يونس عليه السلام فاستجاب له سبحانه فعطل نواميس الكون فلم يهضم الحوت يونس، كما يقول تعالى((فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين))الأنبياء/88، ودعاء أيوب عليه السلام فأزال عنه المرض المعضل وأعاد له زوجته فتية لتنجب له الأبناء، قال تعالى((فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين))الأنبياء/84، ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يهبه سبحانه ذرية طيبة فوهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق، قال تعالى((الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء))إبراهيم/39.
هل نُسأل عن أفعال من قبلنا؟
قد يفهم البعض معطى الآية الكريمة((تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولاتسألون عما كانوا يعملون))البقرة/134، وتكررت في/141 فهماً سلبياً يبرر له ما يعتقد بخصوص ما فعله السلف.
فالقرآن الكريم مشحون بأخبار الأمم السالفة، وأراد منا سبحانه وتعالى أن ننظر(نتأمل)فيما فعلت ولاقت من مصير، يقول تعالى((قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين))آل عمران/137.
ويريد بذلك سبحانه أن يعلمنا أن الحاضر يستلهم من الماضي العبر والدروس؛ ليصنع حاضراً متميزاً من خلال قواعد يبنيها لينطلق منها إلى مستقبل يخضع لتخطيط مدروس، ومن يقتصر نظره على الماضي أو يتقوقع في الحاضر سوف يخسر المستقبل.
والحديث عن تجارب الآخرين في ما مضى لا يعني أننا نعيش نفس ظروفهم، إنما تكون رؤية نقدية وناضجة نستفيد منها لصنع حاضر ينسجم مع ظروفنا من خلال الانفتاح على العلم والاستفادة من وسائل الاختراع و تسخير الوسائل الطبيعية، فما عملوه في الماضي إن كان زيناً يكون منطلقاً إلى ما هو أحسن، وإن كان شيناً لا يكون عذراً لنا في السير على نهجهم، فقوله تعالى(ولاتسألون) أي أنكم لاتتحملون أوزارهم، فنحن مسؤولون عن جيلنا وعن أمتنا.
وهو - سبحانه - لم يقل لا تَسألون(بالبناء للمعلوم) إنما قال لا تُسألون(بالبناء للمجهول)، فهو لم يمنعنا أن نسأل عما فعلت الأمم التي خلت، ولكن يريد أن يعلمنا أن السلف الماضي لا ينفعنا انتسابنا إليهم، إنما ينفعنا ما نعمل من خير يعم نفعه الجيل الذي نعيش معه، كما يريد منا أن نكون معتدلين فلا نبغض الآباء ولانقدسهم.
وقد يفهم البعض الآية الكريمة -من الذين يتذرعون بتصحيح الجرائم التي ارتكبها السلف- فهماً سلبياً، فيترحم على القاتل والمقتول أو الجلاد والضحية، فينتج عن ذلك خلط بين الحق والباطل، أو هو جمع بين الولاية والبراءة، والمنطق يقتضي بعدم الاجتماع.
وسياق الآيتين اللتين تكررتا يختلف، فالآية الأولى تتحدث عن مجموعة من أهل الكتاب الذين يحملون نظرة ضيقة للماضي ويتفاخرون بالسلف، فتأتي الآية الكريمة لتؤكد أن التدين الحقيقي هو اتباع الخط التوحيدي الخالص غير المشوب بالشرك.
أما سياق الآية الثانية فجاء ليؤكد للمسلمين أن((قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)).
فمن غير الصحيح أن ننطلق من محور الذاتية في الحكم على هذا النبي أو ذاك، بل يجب أن ننظر إلى الأنبياء نظرة رسالية ونتأمل مواقفهم بشكل موضوعي.
ومورد الآية الكريمة ينفعنا أيضاً في تصحيح نظرتنا –ليس فقط فيما يخص الأنبياء ورسالاتهم- بل يعم نظرتنا إلى السلف من آبائنا وأجدادنا وأقاربنا في أن لا تكون النظرة إليهم نظرة ذاتية بعيدة عن الاعتدال والموضوعية.
فوائد دراسة السنن التاريخية، منها:
لابد في حركة البشر من سنن.فتعرض الأنبياء والأوصياء والمصلحين إلى القتل والأذى ونيل الاستشهاد هي سنن تاريخية.
كيف تتقدم المجتمعات وترتقي وكيف تتخلف وتتراجع في منظومتها الأخلاقية؟
1-تعين على دراسة الأحداث التاريخية، وتدخل في قواعد التحليل لما يمر به العالم اليوم، فنحن لايمكن أن نفهم التاريخ ونحلل الأحداث بدون معرفة السنن الإلهية، حتى علم استشراف المستقبل لايستغني عن معرفتها، فمن خلالها نعرف عوامل بناء الحضارات وسقوطها وهدم دول وبنائها أو انتصارها وهزيمتها.
2-تعين على إيجاد الحلول للمشكلات التي يعاني العالم، إن كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
3-تعين على إيجاد الحلول لفك العقد النفسية التي يعاني الفرد والمجتمع.
4- تساعدنا في فهم الواقع في خضم التحولات السريعة التي يمر بها العالم، وفي ظل النظريات والأطاريح القائمة على فهم واستقراء ناقص، ينقصه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فنحن نعيش ضعف دول وسقوط أخرى، وضعف اقتصاد وتقوية آخر، وتبدلات في مراكز القوى في العالم، حتى على مستوى الكوارث الطبيعية كحدوث الزلازل والأعاصير وغيرها التي في الغالب تكون عقوبة وإنذاراً للإنسان على معاصيه.
5-من وعى السنن يستطيع أن يستدل على عواقب الأمور، وما ستؤول إليه الأحداث، وهذا هو شأن المؤمنين الواعين للمرحلة التي يعيشونها والدور الذي ينبغي أن يقوموا به، كخطاب مؤمن آل فرعون لقومه واستشرافه لما ستؤول إليه الأحداث، وماذكر في القرآن الكريم من خطاب الطليعة المؤمنة لمن انبهر بملك قارون وما اكتنزه من زخارف الدنيا، ثم آل إلى الخسف والزوال.
المذهب التاريخي في القرآن
الرعاية الإلهية وهي العامل الثالث في حركة التاريخ، ولاتحسبن عجلة التاريخ قادرة على الاستمرار بدونها، كما لايمكن أن يستقر التاريخ على أساس(الحتمية العلية)و(العنصر الإنساني) فقط، كما أنها تحول دون سقوط الحضارة الإنسانية، والرعاية الإلهية غير السنن الإلهية في التاريخ، إنها شيء مافوق السنن الحتمية، ولولا هذه الرعاية الإلهية التي واكبت حركة التاريخ لسقطت الحضارة البشرية منذ عهد طويل، وكم مرة شهد التاريخ سقوطاً حتمياً لحضارة الإنسان على يد طغاة مجرمين من أمثال جنكيزخان وهولاكو وهتلر لولا أن تدرك الرعاية الإلهية الإنسانية في الوقت المناسب إن الحقيقة التي تكمن وراء ذلك كله أن حضارة الإنسان لايمكن أن تقوم على دعامتين فقط:
1-إرادة الإنسان وسنن الله في التاريخ.
2-ومن دون وجود هذه الدعامة الثالثة(الرعاية الإلهية)تبقى الحضارة الإنسانية متأرجحة وقلقلة ومعرضة للسقوط والانهيار، ومن عجب أن هذا العنصر الثالث البالغ الأهمية يختفي بشكل عجيب في الدراسات العلمية التي تتناول تفسير التاريخ والحضارة الإنسانية، والرعاية الإلهية تواكب الإنسان في مسيرة حياته عند كل مزلق من مزالق الحياة، ولذلك ورد في الأدعية: اللهم لاتكلني إلى نفسي طرفة عين)و(ولو تكلني إلى حولي لكان الحول عني معتزلاً).
وقد ورد التعبير عن هذا العنصر الثالث في النصوص الإسلامية بـ(التوفيق) كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: (التوفيق عناية)و(التوفيق عناية الرحمن). والتوفيق لايأتي بمعنى تعطيل دور قانون العلية في الحياة والطبيعة والمجتمع، وإنما يأتي بمعنى(توجيه الأسباب للإنسان نحو الخير).؟؟؟
ماهو ميدان السنن التأريخية؟
تحوي الساحة التأريخية على حوادث وقضايا تكون في دائرة اهتمام المؤرخين، فهل تحكم سنن التاريخ جميع الحوادث؟
هناك في الحياة حوادث فيزيائية وفسلجية يتعرض لها الإنسان كالولادة والموت وما يقع عليه، ويمر به من حوادث، منها ما نطلق عليه حوادث عابرة ومنها يقع في اهتمام المؤرخين ويكون له أبعاد، مثلاً موت أبي طالب وموت خديجة في سنة واحدة كان حادثة تأريخية مهمة دخلت في نطاق اهتمام المؤرخين ولها بعد تاريخي؛ لعظمة الشخصيتين في تأريخ الإسلام، ولكن لاتحكمها سنة تأريخية، بل تحكمها قوانين فسلجية، فسنن التأريخ تحكم ميداناً معيناً من الساحة التاريخية، ولكن هذا الميدان يشتمل على ظواهر متميزة تميزاً نوعياً يميزه عن سائر الظواهر الكونية والطبيعية.
فالمميز العام للظواهر التي تدخل في نطاق سنن التأريخ هو أنها تحمل علاقة جديدة لم تكن موجودة في سائر الظواهر الأخرى الكونية والطبيعية والبشرية، فالظواهر الكونية والطبيعية كلها تحمل علاقة بين مسبب وسبب، بين نتيجة ومقدمات، كظاهرة غليان الماء ونزول المطر والزلازل إلخ، لكن هناك ظواهر على الساحة التأريخية تحمل علاقة من نمط آخر، هي علاقة ظاهرة بهدف، علاقة نشاط بغاية، أو ما يسميه الفلاسفة(العلة الغائية) تمييزاً لها عن(العلة السببية) كغليان الماء بالحرارة يحمل علاقة سببية ما لم يتحول إلى فعل إنساني وإلى جهد بشري، بينما العمل الإنساني الهادف يحتوي على علاقة مع غاية غير موجودة حين إنجاز هذا العمل، وإنما يترقب وجودها، أي أن العلاقة هنا علاقة مع المستقبل، لا مع الماضي، فالغاية دائماً تمثل المستقبل بالنسبة للعمل، بينما السبب يمثل الماضي بالنسبة إلى العمل.
فالعلاقة التي يتميز بها العمل الذي تحكمه سنن التأريخ هو أنه عمل هادف، عمل يرتبط بغاية، سواء كانت صالحة أم طالحة، من طبيعتها أنها تمنح العامل الطموح والتطلع إلى المستقبل، فالمستقبل أو الهدف يشكل الغاية للنشاط التأريخي ويؤثر في تحريك هذا النشاط وفي بلورته من خلال الوجود الذهني، وهذا يؤثر في إيجاد هذا النشاط.
فكل عمل له بعدان أساسيان: الأول: السبب، والثاني: الغاية، والعمل الذي تحكمه سنن التأريخ لا بد أن يكون له بعد ثالث، وهو: أن يكون له أرضية تتجاوز ذات الفرد إلى المجتمع الذي يكون هذا الفرد جزءاً منه، يعني: عمل إنساني يكون له صدى وموج يتعدى الفرد العامل، ويتخذ من المجتمع أرضية له.
إذن العمل التأريخي الذي تحكمه سنن التأريخ هو العمل الذي يكون حاملاً لعلاقة مع هدف وغاية، ويكون في نفس الوقت ذا أرضية أوسع من حدود الفرد.
ونلاحظ في القرآن الكريم أنه من خلال استعراضه للكتب الغيبية الإحصائية التي تحصي على الإنسان أعماله وعلى الأمة أعمالها، تحدث عن كتاب للفرد يحصي أعماله، يقول تعالى:((وكلَّ إنسانٍ ألزمناهُ طائرهُ في عنقه ونخرجُ لهُ يومَ القيامةِ كتاباً يلقاهُ منشوراً.اقرأ كتابكَ كفى بنفسك اليومَ عليك حسيباً)) الإسراء/ 13-14، وكتابٌ للأمة تحاسب فيه على أعمالها يوم القيامة كما قال تعالى: ((وترى كلَّ أمة جاثية كلُّ أمة تدعى إلى كتابها اليومَ تجزون ما كنتم تعملون)) الجاثية/28-29.
أقرأ ايضاً
- مباحثات امريكا ـ ايران ضوء في نهاية النفق المظلم
- وقفة على قرار منع استيراد مواد ورفع التعرفة الجمركية لأخرى
- اثار رفع الرسوم الكمركية على الدولار والنفط